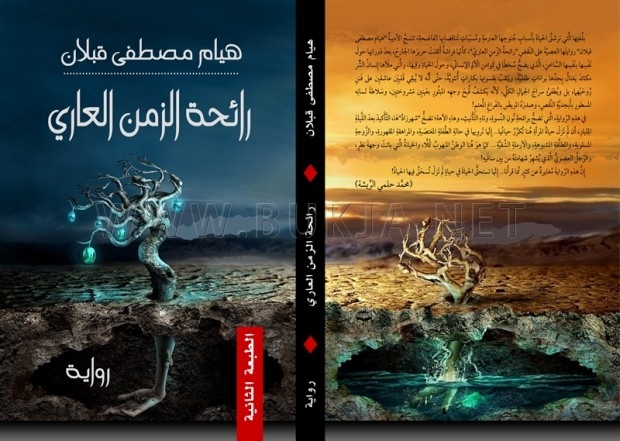قراءة في روايتها، “رائحة الزمن العاري”[1]
مقدمة
الكتابة، والسرد منها بشكل خاص، تشكّل بالنسبة للكاتب ملاذا وخلاصا، خاصة عند شعوره بالانحدار إلى نهاية مرفوضة تؤرّقه. يلجأ الإنسان إلى الكتابة، عندما يكون مقهورا، سواء انفردت بقمعه سلطة ما، أو تعاونت على قمعه وقهره، سلطات رجعية مختلفة اتخذت من القمع سلاحا تقهر به معارضيها، بسادية ووحشية، لتضمن سلوكهم في المسار الذي تُحدّده أو بلوغهم النهاية التي ترسمها. والأمر يبدو ضربا من البديهة عندما يكون هذا الإنسان امرأة تعيش في مجتمع مركّب تُعاني فيه بشكل مزدوج إن لم يكن أكثر. لذا ليس غريبا أن تبحث المرأة، كامرأة وكإنسان، عن خلاصها في الكتابة. وعند توجّهها إلى الرواية تحديدا، ذلك يعني أدراكها للمساحات الورقيّة والنفسية والإبداعية الواسعة التي يُتيحها لها هذا اللون الأدبي الذي بدأ مؤخرا يأخذ دوره اللافت في أدبنا المحليّ، بعد أناحتلّ في العقود الأخيرة موقع الصدارة بين الألوان الأدبية المختلفة، في العالم العربي والعالم بأسره، حيث دحرت الروايةُ الشعرَ واحتلّت مكانه إن لم يكن مكانته أيضا.
تأتي هذه الدراسة لتتعرّض لحالة تؤكّد ما تقدّم، حيث أثبت السرد فاعليته والشعر تراجعه، إذ لم يُسعف الكاتبة / الشاعرة، هيام قبلان، أنّها بدأت مشوارها الأدبي كشاعرة، تركت فيه بصمتها الخاصة، بعد سبع مجموعات شعرية أصدرتها تباعا. ولكنّ تلك المجموعات، على ما يبدو، لم تحقّق لها الخلاص. قراءتي لهيام قبلان الشاعرة، قليلة جدا، لدرجة أنّها لا تفي بحاجة المتعة الأدبية، فما بالك بالحاجة إلى النقد الأدبي؟! ومع ذلك، أرى واثقا، أن سبع مجموعات شعرية، مهما تألّقت فيها الشاعرة، لم تكن كافية لإنقاذها، لأنّ الشعر، حبيبها الأول، خانها، ذلك لأنّ كل ما كتبته من قصائد لم يزد على أن وضعها أمام الحقيقة بجلائها ومرارتها، “خلاصك ليس في الشعر فابحثي عنه في مكان آخر، أو مع حبيب آخر أكثر إخلاصا وأقدر خلاصا”. الشاعرة فهمت الرسالة ولم تتوانَ، فنفضت عنها حبيبها الأول، الشعر، وارتمت في أحضان مخلّصها: الرواية. ذلك أمر أتفهّمه ولا يشكّل أية مفاجأة بالنسبة لي، لأنّي أعتقد أنّ لمح الشعر وكثافة مفرداته لم يتركا للشاعرة المساحة الكافية للبوح، بينما وعدتها الرواية بلانهائية المساحة، وبإمكانات لا محدودة من الحفر أكثر وأعمق في طبقات النفس واللاشعور لتنفث الكثير مما بقي مدفونا في طيات لاوعيها، ولتبوح بمكنونات نفسها وخباياها التي عجز الشعر عن بلوغها وكشفها. والكاتبة لا تخفي ذلك العجز، حين تطرح في روايتها تساؤلا إنكاريا فيه إشارة إلى تزعزع مكانة الشعر في نفسها وشكّها بقدرته على توفير الخلاص لها، إذ تقول في روايتها: “هل الحبّ للحبيب الأول كما يقول الشعراء؟!” (ص 29). وتتساءل في مكان آخر: “هل للشّعر الّذي يُغنّى على شوارع القهر طعم الأرق والغربة؟” (ص 167).
الشاعرة والكاتبة، هيام قبلان، مبدعة رواية “رائحة الزمن العاري”، هي كاتبة عربية فلسطينية، أعتقد أنّها عن قصد لم تُشر في روايتها، إلّا بالتلميح الذكيّ، إلى انتمائها للطائفة العربية الدرزية التي تعيش في إسرائيل، وذلك تأكيدا لعروبتها وعروبة طائفتها معا، تلك الحقيقة التي عجزت المؤسسة الصهيونية الحاكمة في إسرائيل عن دثرها، رغم كل محاولاتها طيلة عقود وجودها، نَزْعَ تلك الطائفة من جذورها العربية. لذلك تأتي رواية هيام قبلان، وإن لم يكن بالدرجة الأولى، صرخة فاجعة وفاضحة في وجه السلطة الإسرائيلية، وفي وجه ما تنتهجه من سياسات همجية ضد العرب، أصحاب الوطن الأصليين، وأهمّها: اغتصاب الأرض والتمييز العنصري وسياسة “فرّق تسد”.
ولكنّ هيام قبلان، التي تتماهى مع “هزار”، بطلة روايتها، قبل معاناتها من ظلم السلطة الإسرائيلية، وكغيرها من نساء مجتمعنا، عانت وما زالت تُعاني من ظلم مجتمعها العربي الأبوي الذكوري المتخلّف. ولذلك، فإذا كانت القضية الفلسطينية عامة، وقضية الإنسان العربي في إسرائيل بشكل خاص، تحتل مساحة بارزة في الرواية ومضامينها، فإنّ معاناة المرأة في المجتمع العربي وقمعها فيه كمجتمع أبوي ذكوري متخلّف، يحتلّان فيها المساحة الأوسع والأبرز. وتلك هي الصرخة الأقوى والأهمّ للرواية وكاتبتها، لأنّ هذه المعاناة هي الأسبق تاريخيا، وتأتي من المجتمع الذي تعيش فيه الكاتبة، وتُظلم فيه المرأة عامة، وتحديدا من ذوي القربى الذين يُفترض أن يكونوا حماية لها، لا أن يتعاونوا مع عدّوها وعدوّهم على قمعها. وبذلك تكون هيام قبلان شأنها شأن غيرها من الكتاب الفلسطينيين، الذين إمّا أن يكتبوا عن الهمّ الفلسطيني، فرديا كان أم جمعيا، وإمّا ألّا يستطيعوا تجاهله في أعمالهم مهما كانت أنواعها الأدبية ومهما تعدّدت مواضيعها.
من حيث الشكل والمضمون، تنتمي الرواية إلى ما يُسمّى بـ “الأدب النسوي” الذي ينعكس في الرواية بجوانبه المختلفة، مثل: مواجهة الثقافة الأبوية الذكورية، والرؤية الأنثوية للعالم، واحتفاء المرأة بجسدها خاصة وبالجسد عامة، من خلال علاقتها بالرجل أو المرأة. ولكنّ ذلك لا يخفي النزعة الإنسانية في الرواية، بل يُبرزها ويجعلها تطغى، خاصة عندما تتداخل وتتقاطع الهموم الفردية للكاتبة أو بطلة روايتها، بهموم الأنسان والوطن. ومن حيث الشكل فقط، لجأت الكاتبة في روايتها إلى الكثير من ملامح الشكل السيري، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من الاستفادة من التجريب، ومن الراوي العليم (كليّ المعرفة)، لتبعد عنها شبهة السيرة الذاتية، رغم ما في الرواية من تداخل بين صوت الراوي العليم وصوت “الأنا” الراوي والمروي عنه. تستعين الكاتبة أيضا بتقنيّات تيار الوعي التي تساهم في إبعاد الشبهة المذكورة، وتمكّن الكاتبة في الوقت ذاته من أن تجوب الأزمنة داخل الرواية بسهولة أكبر رغم صعوبة تداخلها وتقاطعها، وتمكّنها أيضا من الغوص بشكل أعمق في طبقات اللاشعور. يُؤكّد ذلك، توظيف الكاتبة لتقنيتي الاسترجاع والمونولوج المباشر وغير المباشر.
“رائحة الزمن العاري”، هي طرح جريء جدا لقضية المرأة العربية في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي هو امتداد للمجتمع الفلسطيني والعربي عامة. وهي تجسيد لمعاناتها المزدوجة: الأولى، كامرأة تعيش في مجتمع عربي أبوي ذكوري متخلّف، ما زال يرى في المرأة جارية الرجل ولعبته، يقمعها ويهمّش دورها متى شاء، جاهلا أحيانا ومتجاهلا أحيانا أخرى، أنّ حريّته لن تتحقّق ما لم تتحقّق حرية المرأة. والأخرى، معاناتها كإنسان عربي يعيش في إسرائيل، تعمل السلطة السياسية على خنقه وهضم حقوقه. والمرأة العربية في هذا المجال، لا تختلف عن الرجل العربي، الذي تطالبه الكاتبة أن يعي كلا الحقيقتين.
قرأت الرواية فوجدتها تستحقّ الاهتمام والنقد الجادّ، أكثر مما حظيت به حتى الآن، رغم أنّها ليست كما ادعى أحد نقّادها، ترقى إلى “مصاف الأدب العالمي الرفيع”، الأمر الذي أيقظ نرجسية هيام قبلان وجعلها تكرّر قوله في أحد اللقاءات معها. من الممكن أحيانا، أن أتفهّم نرجسية المبدع، ولكن، من الصعب أن أتفهّم سذاجته. والحقيقة أنّني لم أتوقّع من مبدعة الرواية أن تكون بهذه السذاجة مهما أطربها الثناء. ولكنّ موقفي هذا، من سذاجة الكاتبة ونرجسيتها، لا يُشكّل طعنا بقيمة الرواية وتميّزها، إذ من حيث الشكل استطاعت قبلان أن تقدّم ما أثبت قدرتها في أكثر مجالات السرد تعقيدا، الرواية. ومن حيث المضمون، صحيح أنّه على مستوى الأدب النسوي العربي عامة لم تقدم هيام قبلان جديدا، فقد سبقتها إلى ذلك الكثيرات، ولكن على مستوى الأدب النسوي الفلسطيني، وخاصة داخل الخط الأخضر، فقد انطلقت قبلان من موقعها الاجتماعي والجغرافي، وعالجت بجرأة غير متوقّعة وغير مسبوقة، قضيتين، لكل منهما حساسيتها الخاصة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد: الأولى، قضية المرأة عامة في المجتمع العربي في إسرائيل وارتباطها بالهمّ الوطني، والثانية، قضيتها الخاصة التي تنحصر في موقع اجتماعي له خصوصيته داخل المجتمع العربي في إسرائيل، هو مجتمع الطائفة العربية الدرزية التي تتميّز بكونها محافظة أكثر من غيرها من شرائح المجتمع العربي.
قرأت الرواية بعد صدورها بطبعتها الثانية، (2012). ربما كان هذا التأخّر في القراءة ذا فائدة، إذ مكّنني من قراءة ما كُتب حولها من أعمال نقدية بعد صدورها الأول، (2010)، فوجدت أكثره يستبدّ به الحماس العاطفي (قدّمت نموذجا لذلك)، رغم ما فيه من جودة أحيانا، ووجدت بعضا منه جادّا وموضوعيا، إلّا أنّ أيّا من تلك الأعمال لم يُفسح للرواية المساحة الكافية لتفكيكها وسبر أغوارها شكلا ومضمونا، وليكشف عمّا فيها من مضامين قصدتها الكاتبة وعبّرت عنها بلغة مباشرة أو غير مباشرة، وما في بنائها من مواطن الضعف والقوة. تطمح هذه الدراسة إلى أن تسدّ بعضا من ذلك النقص.
مضمون الرواية
في حديث لها حول روايتها، تقدّم الكاتبة قضية الوطن على قضية المرأة، إذ تقول هيام قبلان في مقابلة معها: “إنّ الرواية بحدّ ذاتها (تقصد روايتها “رائحة الزمن العاري”) تعتبر تحدّيا كبيرا لكل من احترف العمالة والفساد ضد الوطن، فهي تتحدث عن القضية الفلسطينية، وعن معاناة المرأة داخل مجتمع ذكوري لا يزال ينظر نظرة دونية للأرملة والمطلقة”.[2]وأنا أتّفق معها في مضمون حديثها، ولكنّي أرفض الترتيب الذي أشارت إليه، إذ أرى أنّ تقديم القضية السياسية أو قضية الوطن على قضية المرأة، في اللقاء المذكور، هو نوع من الدعاية للرواية، كان يجب على الكاتبة أن ترفضه، أولا، لتترك روايتها تسوّق نفسها بنفسها، وقد فعلت الرواية ذلك بشكل ملموس، والدليل هو صدورها في طبعة ثانية. وثانيا والأهمّ، هو أنّ الدافع الأساس لكتابة الرواية كان قضية المرأة وليس قضية الوطن. قضية المرأة الخاصة والعامة، أو الفردية والجمعية، كانت هي الإثارة، ومن خلالها فقط، تكشّف التماهي بين قمع المرأة واغتصاب حقوقها، وبين اغتصاب الوطن الذي تمّ بمشاركة بعض أبنائه، الذين قمعوا المرأة أولا ثم تحوّلوا إلى عملاء وسماسرة، وظّفوا عمالتهم على حساب الوطن لتحقيق مآربهم الشخصية. تقول البطلة بعد موت أختها “دلال”: “لم ترحمك ألسنة اللهب في القرية، فهل استشهادك في سبيل انسانِكِ وكيانك كان شهادة؟ لو أنّ موتك كان في سبيل الوطن، لنثروا على قبرك الورود، وكللوك بأوراق الغار، وتوّجوك أوسمة البطولة مثل أيّ “شهيدة” (أي سيتظاهرون نفاقا بحبّ الوطن)! وهل بقي خيتاه وطن (والقصد، قد باعه هؤلاء العملاء والسماسرة المنافقون)؟” (ص 30). وتقول: “أنت يا دلال غدوت رقما بين أرقام النساء التي اغتيلت حيّة، وكما اغتيلت وصودرت آلاف الدونمات من أراضي القرية بدم بارد (ص 32). وتعني بذلك مصادرة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لما تبقّى من أراضي القرى العربية بما في ذلك أراضي قرى الطائفة العربية الدرزية التي لم يسعفها أنّ أبناءها يخدمون في الجيش الإسرائيلي. في العبارتين السابقتين، ذكرت البطلة اغتيال أختها الاجتماعي أولا. وهي إشارة واضحة إلى تقديم قضية المرأة على قضية الوطن في الرواية، وإشارة إلى أنّ قمع المرأة سابق، وأنّ إهمالها سبب من أسباب إهمال الوطن، وأنّ الرجل الذي يُفرّط بالمرأة يُفرّط بالوطن. ومهما يكن من أمر، فإنّ ذلك يظلّ همّا جمعيا يُؤرّق كل فلسطيني، فكما أسلفت، لم يستطع معظم الكتّاب الفلسطينيين تجاهله، مهما كان نوع كتابتهم وموضوعها. ولكن، هل يقف الأمر في الرواية عند هذين الموضوعين المختزليْن بتلك العبارة التي ذكرتها الكاتبة؟ لا شكّ أنّهما الموضوعان الرئيسان اللذان تدور حولهما أحداث الرواية، ولكنّ طيّات الرواية تحمل الكثير مما يجدر الالتفات إليه، وضرورة تفكيك عناصره، شكلا ومضمونا، لكشف دلالاته، ولتتضح لنا الصورة أكثر بعد تفكيك الرواية وإعادة بنائها.
قمع المرأة، التاريخي والراهن
ليست الرواية، التي بين أيدينا، صرخة ضدّ قمع المرأة الأرملة أو المطلّقة فقط، كما ذهبت الكاتبة وبعض قرّاء الرواية أو نقّادها، وإن كانت هذه الشريحة من النساء بارزة فيها. ولكنّها صرخة ضدّ قمع المرأة عامة، المرأة الضحيّة في أيّ مجتمع أبوي ذكوري متخلّف، وبشكل خاص في المجتمع الذكوري العربي الذي يقمع المرأة قبل كونها مطلّقة أو أرملة، وبعده أيضا، أي ليس شرطا أن تكون كذلك. قمع المرأة في مجتمعنا، كأرملة أو مطلّقة، هو استمرار لقمعها منذ كانت، وإن كنّا لا نستطيع أن ننكر أنّ المجتمع الذكوري يفتح عينيه بشكل أوسع على المرأة الأرملة أو المطلّقة، خاصة عندما تكون شابة. من جهة لأنّ وضعها الاجتماعي الجديد يُبرز مفاتنها الجنسية التي كانت محمية برجل شرعي خرج من حياتها بالطلاق أو الموت، فأصبحت في نظر المجتمع مشاعا يفتح شهيّة الطامعين بها. ومن جهة أخرى، الوضع الجديد يفتح عيني المجتمع على المرأة، تخوّفا من تجربتها في الحياة وتراكم خبراتها ومعرفتها بحاجاتها الجسدية والنفسية، وبحقوقها أيضا، ما يجعلها في كثير من الأحيان أقوى في سعيها لتحقيق تلك الحقوق، وأقدر على مواجهة المجتمع في نضالها من أجل حريّتها. ومن جهة ثالثة، لأنّ ما تقدّم يُشكّل خطورة على المجتمع كمجتمع ذكوري يُهيمن عليه الرجل الذي تتهدّد هيمنته، فكلما زادت معرفة المرأة وخبرتها في الحياة وقوتها وقدرتها على المواجهة، زاد تهديدها لهيمنة الرجل. وذلك يدفعه إلى زيادة القمع، أضعافا مضاعفة أحيانا، وإلى تطوير وسائله التي تخرج عن تقليديّتها، خاصة عند دخول عناصر جديدة أو غير متوقّعة في صلب شبكة العلاقات المتعارف عليها في المجتمع الذكوري. من هذه العناصر مثلا، السلطة السياسية التي لها طابعها الخاص في إسرائيل، فهي تدّعي الحرية والديمقراطية، ولكنّها تبذل الجهود المتواصلة لتُبقي على الوضع القائم في المجتمع العربي، الوضع الذي يكرّس الفرقة والتخلّف في المجتمع ويضمن للسلطة استمرار تناحره وهيمنتها.
ولتأكيد شمولية القمع ضدّ المرأة، واستمراره من مولدها حتى موتها، لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ بعض الشخصيات النسائية في الرواية، هي شخصيات دخلت سريعا حياة البطلة لتطرح فكرة أو تؤدّى دورا يخدمها، ثم خرجت سريعا كما دخلت، أو هي شخصيات غير كاملة، وإنّما أجزاء لشخصية واحدة، هي شخصية البطلة، امتنعت الكاتبة عن جمعها لتتمكّن من أن تُعبّر في كل جزء عن فكرة أو مجموعة من أفكارها التي لا تتسع لها شخصية البطلة وحدها. وبالإضافة إلى ما تقدّم، استطاعت الكاتبة بذلك التجزيء، أن تُشير إلى قضيتيْن متناقضتين في مجتمعها: من جهة التشظّي الذي يُعاني منه المجتمع أفرادا وجماعات، نفسيّا واجتماعيا، ومن جهة أخرى حاجة المجتمع إلى التكامل الذي لا يُدرَك إلّا بانتشار الوعي الذي يضمن للمرأة حريّتها ودورها كشريك ينعم بالحرية والمساواة وتحمّل المسؤولية.
صحيح أنّ “هزار”، بطلة الرواية، تصلُح نموذجا للمرأة الأرملة، التي زادت محاولات قمعها وتشعّبت أشكاله، ولكنّ القمع نفسه لم يبدأ في هذه المرحلة من حياتها. لقد بدأ القمع منذ زمن بعيد، منذ طفولتها المتمثّلة بطفولة “منية”، أختها الصغيرة، التي “لم تُتمّ عامها الأول، فقد قتلتها الحمّى اللعينة” (ص 151). والحقيقة أنّ موتها لم يكن طبيعيا بسبب المرض فقط، فقد اجتمع عليها المرض والتخلّف وظلم المجتمع، “فقتلوها بتداول عاداتهم البالية في التداوي والشعوذة” (ص 170)، ما يُشير إلى إهمال المجتمع للمرأة، ولامبالاته بموت طفلة لا قيمة لها، من المفضّل التخلّص من تهديدها للمجتمع بكونها مشروع عارٍ قادم. وفي ذلك إشارة إلى وعي الكاتبة لتاريخية القمع في المجتمع العربي. وعادة وأد البنات الجاهلية تشهد بذلك. وفيه إشارة كذلك إلى وعيها باستمرارية القمع في مجتمعنا كمجتمع أبوي ذكوري منذ طفولته التي يأبى أن يُغادرها.
وقد تواصل القمع في مرحلة الصبا، وقبل الزواج، في صبا البطلة المتمثل بصبا أختها “دلال” التي تناولت السمّ لأنّها رفضت أن “تبيع نفسها لمن لا تهواه” (ص 28). فقد شكّك المجتمع بعذريتها واتّهمها بالحمل قبل الزواج، “لم يتحرّك في رحمك جنين كما ادّعوا” (ص 30)، فانتحرت قسرا. و”هزار” نفسها، أختار لها أبوها زوجا، ضاربا بعرض الحائط حقّها في الاختيار؟ إذن، “هزار” التي تحمل أفكار الكاتبة ومن هنّ على شاكلتها وتمثّلهن بخصوصية الأحداث، وتمثّل المرأة عامة بشمولية القمع، “هزار” تلك، هي امرأة مقموعة منذ طفولتها، وشخصيتها في الرواية هي امتداد للشخصيّتين المذكورتين، كما هي مرحلة الطلاق وغيرها، امتداد لمراحل سابقة: الطفولة والصبا والشباب قبل الزواج، ومرحلة الزواج، كلها مراحل تسبق الطلاق أو موت الزوج، في حين يظلّ المجتمع هو المجتمع ذاته في كل تلك المراحل. تقول “هزار” بعد موت “دلال”، أختها التي انتحرت: “لكنّكِ رحلتِ، وصرْخَتُكِ الصّامتة ما تزال ترنُّ في مسامع وجداني، ترافقني إلىمضجعي، تلازمني وتحثّني: لا تستسلمي يا هزار“ (ص 32). ألا يدلّ ذلك على أنّ خلق شخصية “هزار” كان امتدادا لأختيها، وظلمها كان امتدادا أيضا، وأنّ خلق شخصية “هزار” وبقاءها جاء من أجل التمرّد الذي هو الدعوة الأولى والمركزية للرواية؟
اختيار الكاتبة لكون “هزار”، بطلة روايتها، أرملة وليست مطلقة، أمر له دلالات خطيرة. فالكاتبة تعبّر بذلك عن قسوة المعاناة التي تعيشها المرأة وعمق صراعها الداخلي في البحث عن سُبل خلاصها: هل تقف المرأة مكتوفة اليدين وتضع مصيرها في كفّ القدر وخلاصها بيد الموت، مثلا، موت “منية” وموت زوجها، ذلك الموت الذي يوظّفه القدر في صالحنا أحيانا، وضدّنا غالبا؟ أم تستدعي هي الموت لخلاصها؟ فإذا استدعت الموت وقتلت رجلها، مصدر القمع، فلن تستطيع قتل المجتمع كله، وستكون بذلك قد فقدت إنسانيتها التي تناضل من أجلها، وإذا استدعت الموت وقتلت نفسها، انتحرت، كما فعلت “دلال”، ستكون بذلك قد انسحبت إلى داخلها، وسلّمت بضعفها وعجزها عن المواجهة. وهي إن ضمنت بذلك خلاصها الفردي، فسيكون خلاصا في منتهى السلبية، ولن تضمن به خلاصها الجمعي، بل ستُساهم في إبعاد فرصه. وهذا ما لا تريده الكاتبة التي وظّفت القدر بشكل محدود في موت زوج “هزار” بحادث طرق وموت أختها الصغيرة بالمرض، ووظّفت كذلك الموت انتحارا من خلال شخصية أختها “دلال”، لتعبّر عن جانب من أيديولوجيّتها الرافضة لخلاص المرأة بواسطة الموت أيّا كان شكله. ترفض الكاتبة انتظار القدر أو الانتحار كوسيلة للخلاص، ولذلك ضحّت بـ “منية” الطفلة و”دلال” الصبية، وأبقت على “هزار” المتزوّجة المجرّبة لترفض ذلك المصير وتتمرّد. تمرّد “هزار” هو تعبير عن جانب آخر من أيديولوجية الكاتبة التي تُؤمن بأنّ تمرّد المرأة على المجتمع وقيوده، هو طريق خلاصها الوحيد. وقد وجد تمرّد “هزار” تجاوبا من بنات جنسها، من جارتها “أم فراس”، التي كانت تحمل بذور التمرّد وتحميها، ولكنّها لا تبذرها وتنمّيها. فقد كانت تتصرّف بحرية: تسافر وتعمل وتتمتّع وتحمل هاتفا نقّالا، تتصرّف كما لو كان “لا رقيب على تصرّفاتها” (ص 78)، ولكنّها تخشى المواجهة وتتجنّبها. وبما أنّ اهتمامات الكاتبة أوسع من الاهتمامات الشخصية لشخصيات روايتها، لذلك طورّت شخصيتي “هزار” و”أم فراس” بحيث تتجاوز بهما الهمّ الفردي إلى الجمعي، أولا، في تشجيع “أم فراس” لـ “هزار” وتجاوبها مع حاجاتها النفسية والجسدية إلى أبعد الحدود، وذلك في لقائهما الجسدي الذي عكس حاجاتهما المشتركة وتعاونهما على قضائها. وثانيا، في تربية “هزار” لابنتها “سمر” وإرسالها إلى الجامعة حماية للحاضر وضمانا للمستقبل الذي يُمثل مستقبل المرأة عامة. هذا ما يشغل فكر الكاتبة وما تناضل وتتمرّد من أجله. ما ترنو إليه الكاتبة يهتمّ بحاجات المرأة الشخصية، ولكنّه يتعدّاها أيضا إلى همومها الجمعية، إلى تحرّرها الجمعي الذي هو شرط لتحرّر الوطن.
من هنا، وعلى امتداد الرواية، رأينا البطلة، “هزار”، تلعب أدوارا مختلفة يكمّل بعضها بعضا، معبّرة بها عن أفكار الكاتبة. فهي المرأة العاشقة المقموعة قبل الزواج، فقد أحبّت “نبيل” ولكنّها بسبب القمع، عجزت عن الدفاع عن حبّها والزواج ممن أحبّت. ولكنّ في الوقت نفسه، عجز القمع هو الآخر عن انتزاع العشق من قلبها قبل الزواج وبعده. بعد ذلك يأتي دور المرأة المتزوّجة قسرا من زوج لا تريده، هو “كريم” ابن عمّها، الذي فرضه عليها والدها الذي يتعامل مع زوجته كنعجة. ثم يموت “كريم” لتبدأ “هزار” مرحلة جديدة تلعب فيها دور الأرملة التي، من جهة يراقبها الأخ العميل ويُحصي عليها حركاتها ليمنعها من الانزلاق، متناسيا عار عمالته، كأنْ لا عار في المجتمع إلّا عار المرأة. ومن جهة أخرى يطمع بمفاتنها الطامعون: “الجَنّان”، و”أدهم”، وعمّها، وآخرون كثر، إذ تقول: “نهدايَ فقدا الشّهوة وفتنةَ الحلم، حين امتدّت أوّل يَدٍ لتقطفهُما، ثمّ تلتها يدٌ أخرى وأيادٍ أخريات تحبّ العبث بـ “لعبة النّهودِ”، وما أن تمتدّ يدٌ لتفكّ أزرارَ ثوبي، حتّى تتساقط المسافات بين العُنق والإبط!” (ص 136). ويتوّج هذه الأدوار دور المرأة المتمرّدة على المجتمع بشخصياته الذكورية السالف ذكرها، التي اجتمعت وتحالفت على ظلم المرأة وقمعها. تقول: “كريم، نزار، والدي، خالي، كما صادرَ الوَقت أرضي صادَرْتُم الكَرامَة، وتَعاونْتُم في بيعِ الأراضي، يا سَماسِرة الزّمن في تهجير شباب المستقبل!” (ص 57). تحالفُ تلك الشخصيات يُبيّن أن المجتمع الأبوي الذكوري هو نظام اجتماعي كامل يعمل ضدّ المرأة مستغلا كل الوسائل المتاحة له. وهي بدورها، تتمرّد لتعرّي المجتمع وتفضحه، أو تنتقم منه، أو كليهما معا.
“كريم”، الزوج، يتحالف ويتآمر مع الأب. “كم كرهتْ (هزار) تلك البدلة (بدلة كريم) التي تآمرت مع شاربي والدها على جلد أحاسيسها” (ص 27). ففي حين تبرز “شوارب الوالد” كرمز للسلطة الأبوية والذكورية المهيمنة على المجتمع، تبرز “بدلة الزوج” رمزا للوسائل المتاحة، فهي إحدى الوسائل التي أتاحها واقع كون الزوج مجنّدا في الجيش الإسرائيلي، حيث تصبح “البدلة” رمزا للسلطة بشكل عام. بما أنّ البدلة هي بدلة عسكرية فإنّ لها دلالة أخرى تتعلّق بالسلطة السياسية والقضية الوطنية، ولكنّها موضوع حديث لاحق.
المجتمع الذكوري بوسائله المتاحة، يقمع المرأة، ويكشف نظرته الدونية لها، وتهميشه لدورها، وتكريسه لجسدها كمخلوق تنحصر روحه وقيمته بمدى قدرته على إمتاع الرجل، لا كجسد فيه روح إنسان وله حرمته واحتياجاته. فقد “كان (الزوج، كريم) يهطل شهوته عليها، ويمارس حقّه في جسدها دون اهتمام ببرودة جسدها، وبأسنانها المتلاصقة وعينيها المشدودتيْن بسقف الغرفة” (ص 80). ومن هنا، كان لا بدّ للكاتبة، المتمرّدة هي أيضا، أن تستعين بالموت، لخلاصها أو خلاص بطلة روايتها، لا من الزوج كشخص، وإنّما من الفكر الذكوري الرجعي الذي يُمثّله، الفكر الذي يُكرّس دونية المرأة ويُهمّش دورها ويقتل إحساسها بأنوثتها. وبما أنّ كل نهاية هي بداية، فإنّ موت الزوج يعني بداية مرحلة جديدة في حياتها، اختارت فيها التمرّد طريقا لخلاص سيأتي ذكره.
الأب هو رمز السيطرة والقمع في المجتمع الأبوي منذ ولادة المجتمع، وحتى اليوم. وعلى مستوى الرواية، فقد مارس الأب سيطرته وقمعه على “هزار”، ابنته، منذ ولادتها إلى ما بعد وفاته. تقول: “رميتُ وصيّتك حينما هبّت الريح” (ص 26)، فقد ظلّت “هزار” وفيّة لوصايا أبيها، لم تتحرّر منها بعد موته إلّا بتحرّرها من زوجها الذي قسره عليها وقسرها عليه.
لم يكن هذا هو الجانب الوحيد المظلم في شخصية الأب، كان هنالك جانب مظلم آخر غير السيطرة والقمع المقصوريْن على أهل البيت (المجتمع) عامة، وعلى نسائه بشكل خاص. ذلك الجانب هو احتراف العمالة للسلطة التي اغتصبت الأرض والوطن. ولكنّ هذا الجانب هو موضوع حديث لاحق أيضا، أذكره هنا لأبيّن أنّ السلطة الاجتماعية المسيطرة القامعة في مجتمعنا، تتحوّل إلى مجرّد جسم هشّ مسيطَر عليه ومقموع خارجه، إذ لا يحترف العمالة لعدوه إلّا إنسان ضعيف النفس أسقطه ضعفه بغضّ النظر عن شكل هذا الضعف ونوعه. ولكنّ ما يهمّنا هنا هو تمرّد الأنثى على الجانب المظلم الأول، سلطة الأب (المجتمع)، الذي بغيره لا يمكنها التمرّد على الثاني، العمالة وبيع الوطن. فقد تمرّدت “هزار” أولا على الأب ووصاياه وتعليماته، الأب الذي “يقيم عليها حصارا يوميا … وإقامة جبرية أبدية، مؤطّرا إيّاها بدور ربة البيت، تربي الأطفال وتطيع زوجها، ولا تتكلّم إلّا حين يلزم سماعها” (ص 25). تمرّدت ضاربة بعرض الحائط “القيل والقال وثرثرة نساء القرية (التي) اتّهمتها بالجحود، وعيون أهل القرية (التي) لم ترحمها”، ولسان حال المجتمع يفجّر في مسمعها قنبلته: “من لا تبقى على ذكرى زوجها، تُدعى امرأة دنيّة” (ص 25). لكنّ تلك القنبلة لم تعد في مسمع “هزار” سوى قنبلة صوتية، تمرّدت عليها وعلى “كل الوصايا التي فرضها رجل الغاب” (ن. م.)، الذي حين أطلّ عليها بصورة والدها، “بشاربيه الكثيفين، وبقامته الضخمة الرابضة على أنفاسها” (ن. م.)، خاطبته بلطف قتلته مرارة السخرية وغمرته صرامة التمرّد: “عذرا أبي … رميتُ وصيّتك حينما هبّت الريح” (ص 26). الريح هنا هي ريح الوعي والتمرّد. فق تمرّدت “هزار” جسدا وروحا على المجتمع القامع وقيمه وأعرافه البالية إذ تقول: “لم يعد جسدي ملك أحد … إنه ملك النشوة … ملك المعرفة والحياة” (ن. م.).
ولأنّ الأب لا يمثّل شخصا معيّنا، بل فكرا ومجتمعا، يأتي بعده الابن، “نزار”، ليُشكّل امتدادا لشخصيته وللفكر الذي يمثّله، فكما تقول “هزار”: “منذ ولادته حصل على كل شيء، وبعد وفاة والدي استولى على كل شيء” (ص 39)، ما يعني أنّه سيلعب الدور نفسه، ويحمل الشخصية نفسها، ذات الجانبين المظلمين: القمع والعمالة. على مستوى المرأة، يمارس “نزار” القمع ضدّ أخته “هزار” التي تعتبره “السبب في رحيل دلال” (ص 37)، أختها التي انتحرت قسرا. يراقبها ويحاصرها ويقتحم خصوصيّتها ويُحاول تقييد تحرّكاتها، ويسخر من حبيبها “نبيل” وعلاقتها به، ويلمّح إلى تشريده من الوطن بعد عودته إليه، ويرفض تربيتها لابنتها، “سمر”، الطالبة الجامعية التي تسمح لها بالمبيت خارج البيت، والاختلاط بزملائها، خاصة الذكور، الذين يتجسّس عليهم ويعمل على توريطهم لأبعادهم عن الجامعة وعنها. وعلى مستوى الوطن فهو يمارس العمالة ضد أبناء شعبه، كما سيأتي لاحقا.
في الفقرة التالية، بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى، تظهر شخصية “نزار” بجانبيها المظلمين:
“نزار” الّذي اعتاد أن يطيلَ غيبتهُ، عادَ لِيعلِنَ ناقوسَ الخَطَرْ، ويدقَّ حنجرة السّاعات بغضبهِ المتطاير شرَرًا من عينيه، ودون أن يقرع الباب، دفعَهُ بقوّة، متوجّهًا إلى غرفة الاستقبال، مزمجرًا في وجه “هزار”:
– ما بالُكَ … أجُننتَ؟
– كيف تسمحين لـ “سمر” بالمبيت خارج البيت؟ ومُنْذُ متى تتجوّلين حضرتُكِ حتّى مغيب الشّمس؟!
اشتعلت النّيران داخلها، وبانَ الغضبُ على ملامح وجهها، لكنّها بادرتْهُ بالأعذار (الاعتذار) قائلة:
– مِن حقّ “سَمر” في الجامعة … وسَفرُها لا يتعدّى يوميْن وتعود، ثمّ إنّ هذه رحلة نهاية السّنة الدّراسيّة، وصديقاتها معها وليست لوحدها!
– وماذا عنكِ أنتِ السّيّدة المُكرَّمة … صاحِبة الرّزانة والعِفّة والطّهارة … أيخلو لكِ الجوّ؟!
– ماذا عنّي؟ كأنّي بكَ تهزأ بي وبوقاري.
نظر “نزار” للّوحة المعلّقة على الحائط، والّتي تستنهض في داخلهِ الطّفل الصّغير الشّرّير ويثور:
– لن تتجوّلي بلوحاتكِ بعد الآن، ولن أدعكِ تسافرين للمدينة وحدكِ … أفهمتِ؟
– هل تُنصّب نفسك وصيًّا عليّ الآن؟ منذ متى وأنت تهتمّ بي وبابنتي “سمر”؟
– أنتِ لا تسمعين ما أسمعهُ، وتريدين لنا الفضيحة مع السّيّد “نبيل” هذا؟ الفارس العائد من بلاد الغربة محتاج لحنانِكِ؟ (ص 115).
الضربة التي لا تقصم ظهرك تقوّيك. ضربتان قاسيتان تلقتهما “هزار” من مجتمعها المتمثّل بأبيها وأخيها: الأولى، الظلم بما فيه من قمع وهيمنة يسلبان المرأة كيانها كإنسان وكأنثى. وقد أسلمها ذلك الظلم إلى حالة مرعبة من الضياع والاغتراب. والضربة الثانية التي زادت ضياعها واغترابها عمقا، هي عدم اكتفاء الأب والأخ بتطبيق فكرهما الذكوري المتخلّف عليها، إذ سقطا في مستنقع السمسرة والعمالة. ورغم قسوة الضربتين لم تستسلم “هزار”، بل قاومت وتمرّدت. وبرزت قوّتها ليس في تمرّدها على الأب والأخ وما يمثّلانه من تخلّف الفكر الرجعي وحقارة النفس العميلة فحسب، وإنما في مجابهتها لكل الرجال الطامعين الذين يتعاملون معها كجسد خُلق لإمتاعهم وتلبية شهواتهم.
الأرملة والمطلّقة، فريسة المجتمع الذكوري وضحيّته
“هزار”، بطلة الرواية، ومن ورائها الكاتبة، قاومت مجتمعها الذكوري متمثّلا بالطامعين بجسد المرأة الذي يصبح مشاعا في عرفهم عندما ينكبها الطلاق أو الموت. لا يُصرّح الرجال بذلك المتعارف عليه بينهم، لأنّ كلّا منهم يحلّل ذلك الجسد لنفسه ويحرّمه على غيره. يُمثل هؤلاء في الرواية، ثلاث شخصيات هي: “الجَنّان” و”أدهم” والعمّ (عمّ هزار). بالإضافة إلى الطمع بجسد “هزار”، تحمل كلّ شخصية من زاويتها وبطريقتها الخاصة، دلالات أخرى تعبّر عن مكنونات صدر الكاتبة وبطلتها، أو عن بعض أمراض المجتمع.
في قصة البطلة مع “الجَنّان”، التي أعتقد كما سأبيّن لاحقا، أنّها مستوحاة من رواية د. هـ. لورانس، “عشيق الليدي تشاترلي”،[3] تُهيّئ الكاتبة لبطلتها ولـ “الجنّان” كل ظروف الاغتصاب، ولكنها تُفشل تلك المحاولة قبل لحظة انهيار البطلة واستسلامها، لتعبّر بذلك عن بعض أفكارها.
البطلة، “هزار”، التي لم يمسسها رجل بعد موت زوجها، هي أرملة شابة يتحرّق جسدها شوقا وشهوة إلى رجل. فهي “منذ رحيل كريم، لم تُشرّع نوافذ أنوثتها لنسيم رجولة، … لم يرتعش جسدها، ولم يمسسه رجل بعد كريم” (ص 35). الكاتبة لا تبيّن لنا كيف تسلّل “الجَنّان” أثناء دخوله (هجومه) إلى إحدى أكثر زوايا البيت حرمة بعد غرفة النوم، “الحمّام”، ولا أثناء خروجه (هروبه) منه. ولكنّها تُعْلمنا أنّ بطلة الرواية قد “استدعته للاعتناء بالحديقة (حديقة منزلها) منذ عامين” (ن. م.)، الأمر الذي يعني أنّه كانت لديه المدّة الكافية للتعرّف على البيت وأهله، وعلى أسراره الجغرافية وغير الجغرافية. ثمة تساؤلات يُثيرها تصرّف الكاتبة والبطلة: كيف لأرملة شابة أو لامرأة بشكل عام، حتى لو لم تأخذ وضعها الاجتماعي بعين الاعتبار، أن تستعين برجل لا تعرفه وتدعوه لكل هذا الاقتراب من خصوصيّتها، ولم يكن التمرّد أو التحرّش بالمجتمع هو الدافع؟ والأغرب من ذلك أنّها لم تلاحظ خلال عامين ما إذا كان ذلك الذي يعتني بحديقة بيتها لا يطمع بالاعتناء بحديقة جسدها أيضا، مع أنّها أرملة، ولم تكن على توافق مع زوجها قبل موته؟ كيف لم يستوقفها خلال عامين أنّ في جسدها أو تصرّفاتها ما يستدعي فعلة “الجَنّان”؟ هل كانت أبواب البيت مشرّعة أثناء وجودها في “الحمام”؟ كيف لمثلها ألّا تُقفِل الأبواب إذا كانت، في وعيها أو لاوعيها، غير راغبة بما حدث؟ وهي تعرف أنّ “الجَنّان”، شاب قويّ الجسم يتمتع بكل مقوّمات الرجولة، بمعناها الذكوري على الأقلّ. ودوافعه إلى الاغتصاب، كما يُمكن لقارئ الرواية أن يستنتجها، اجتمعت في الظروف المهيّأة: (التربية) التي هيّأها له المجتمع الذكوري، مدعومة بالظروف التي هيّأتها له الكاتبة والبطلة معا، وبالفرصة التي زيّنت له شهوته أنّها واتته، بعد حين طال أم قصُر، من مكابدة الشهوة والتخطيط الأعمى والتربّص بالفريسة والانتظار المتوجّس القلق، ولكنّه، رغم تهيّؤ كل الظروف، فشل في تحقيق رغبته.
أسباب كثيرة دفعت الكاتبة إلى إفشال تلك المحاولة أو ذلك الهجوم. أهمّها ضرورة محافظة المرأة على كبريائها، وامتناعها عن منح جسدها بالقوة ولمن لا ترغب، حتى وإن كان جسدها يتأجّج شهوة. لذلك كبحت “هزار” جماح شهوتها ما استطاعت، قاومت واستنجدت ولم تستسلم، رغم أنّها “تحت وطأة جسده الشبابي المفتول فقدت أنفاسها، وخارت قواها الفتيّة في آتون غضبه الشرس” (ص 36). في تلك اللحظة من الضعف، كان ممكنا أن ينال “الجَنّان” منها، ويقضي وطره منها بسهولة رغم رفضها ودفاعها عن نفسها. تقول الرواية: “إنّها دافعت عن نفسها” (ص 35). العبارة نفسها تثير الإحساس بإنّ دفاعها لم يكن كافيا، عبّر عن ضعفها الجسدي والنفسي أمام قدرات “الجَنّان” الجسدية الهائلة. أصاب “الجَنان” نجاحا جزئيا، والعبارات التي تدلّ عليه: “بكفّيْه الغليظتيْن احتوى نهديْها يمتصّ العنّاب بشفتيْن نهمتيْن، وتناثرَت صرخةُ جسَدِها في فقاعات الصّابون!” (ص 25)، تُعبرّ عن ضعف البطلة ليس أمام قدرات “الجَنّان” فقط، وإنّما أمام حرمانها. هذا الأمر استدعى التدخّل السريع من الكاتبة التي قامت ببساطة متناهية، بذكاء فطري وبسرعة غير متوقّعة، بإنقاذ بطلتها قبل استسلامها، “بيد ابنة الجيران، حين امتدّت تقرع الباب بطفولية هاتفة: خالتي هزار … أريد أن أستلف قليلا من الطحين! … انسلّ الذئب من وكره خائفا … تسلّل هربا وهو يلهث” (ص 36). بذلك أفشلت الكاتبة محاولة الاغتصاب.
بواسطة إفشال المحاولة أيضا، عبّرت الكاتبة عن رفضها القاطع لمثل هذا النهج الوحشي في اقتحام عالم المرأة وخصوصيّتها، وكذلك عن رفضها لاستسلام المرأة له. وأرادت بذلك أيضا أن تضع حدّا للطامعين بجسد المرأة، الذين يتربّصون بها ويستغلّون ضعفها. وبتلك البساطة التي أنقذت بها الكاتبة بطلتها، أرادت ان تُحذّر المرأة عامة، من مدى هشاشة تلك العلاقات التي تقوم بسبب الشهوة والحرمان من غير أن تقترن بالحرية وعناق الروح. فهي تترك في نفسها جروحا لا تندمل. ومن جهة أخرى أرادت الكاتبة أن تنتقص من مكانة الرجل في مجتمعها، ذلك الرجل الذي، مهما كانت مكانته الاجتماعية والثقافية، يفقد وقاره وكرامته ويُشَلّ تفكيره ويسقط عقله بين رجليه كلما لمحت عيناه جسد أنثى. ولذلك جعلت منه الكاتبة مسخا، كما سأبيّن في حديثي عن اللغة.
تقدّم لنا الكاتبة نموذجا آخر من الطامعين بجسد المرأة يختلف عن سابقه. ذلك هو “أدهم” الرسام، أو الفنان المثقّف الذي نجح في استمالة “هزار” إليه من خلال ادّعاء الاهتمام بفنّها ولوحاتها. لقد منحته جسدها بعد تمنّع فأورثها جرحا نازفا، إذ تقول: “كيف لي نسيان الجرح مع أدهم، ونزفه لا زال ينتفض في الحنايا؟” (ص 74). لعلاقة “هزار” بـ “أدهم” دلالات كثيرة أهمّها: 1. حقّ المرأة بالحرية وبتلبية حاجاتها الجسدية متى تشاء مع من تراه يستحق ذلك. وقد فعلت “هزار” ذلك مع “أدهم” من منطلق “الإحساس بالحرية المحاصرة … بالمغامرة وربما التمرّد” (ص 84)، ما جعلها ترى في نفسها إنسانة جديدة تُقرّر: “نعم هذه هزار الجديدة، ولن أتردّد للقائك ثانية يا أدهم، فمن حقّي العيش بقيّة أيامي كما أريد” (ص 86). 2. الرجل الشرقي، بغضّ النظر عن مستواه الاجتماعي أو الثقافي، يفكّر باحتواء جسد المرأة وإشباع رغباته منه دون الالتفات إلى مشاعرها واحتياجاتها. يُؤكّد ذلك أنّ “أدهم”، بعد أن لم تُمكّنه “هزار” من جسدها في لقائهما الأول، لم يهتمّ بأنّها “لم تُبصر رسمته المغطاة بشرشف ورديّ، ولم يهمّه أن ترى اللوحة، إنّما كأيّ رجل أراد إشباع غريزته!” (ص 81). وقد تشاغل عنها أيضا، بعد قضاء وطره منها في لقاء تالٍ، ما يُشير إلى أنّ علاقته بها هي علاقة عابرة غير قابلة للحياة تنتهي فور تحقيق رغبته الجنسية. 3. الرجل الشرقي يرفض الاقتران بالمرأة التي تمنحه جسدها قبل الزواج، حتى لو حدث ذلك برغبتها ورغبته، يُؤكّد ذلك ظهور امرأة ثانية في حياته، ليس بالضرورة يرغب بالزواج منها، ولكنّ فكره الذكوري يُفضّلها على التي منحته جسدها. يُؤكّد ذلك، التعارفُ الذي رتّبه “أدهم” بينهما. تقول الرواية: “نفس الفتاة تتأبّط ذراعَهُ، ولميُدْهَش “أدهم” من وجود “هزار“، إنّما اقتربَ منها قائلاً: أهلا “هزار“ ... الرّسّامة“هزار“، وهذه خطيبتي” (ص 92). 4. ممارسة الجنس مع “أدهم” وقطع العلاقة معه، هما تعبير عن حرية المرأة لممارساتها واختياراتها. أمّا قطع العلاقة بالنسبة للكاتبة فهو تعبير عن رفض الكاتبة لمثل هذا النوع من الجنس الذي يرى في المرأة هدفا لإشباع رغبات الرجل. وهو أيضا تحذير للمرأة التي تغامر بمثل هذا النوع من العلاقات التي تترك آثارا سيئة، وتُخلّف جروحا نازفة لا تندمل، كما سبق وأشرت على لسان “هزار”.
وأخيرا “العمّ”، عمّ “هزار” الذي كان يلاحقها بنظراته قبل موت والدها، وتعهّد، كما تقول: “تعهَّد بشهامة الرّجل القرويّ “ابن البلد”، أن يكون وصيًّا عليَّ وعلى “سمر” مِن بَعدِهِ، أنا الأرملة الوحيدة في العائلة، والوصيّ الأوحدُ في العائلة، هو الوصيّ على الجسد والفكر!” (ص 134). هذه الشخصية تبدو امتدادا طبيعيا لشخصية الأب في سيطرتها، ولكنّها لم تقف عند ذلك الحدّ، بل تعدّته بما لا يقبله عقل ولا ضمير، وبما لا يحدث إلّا في عالم الحيوانات، إذ استغلّ العمّ وصايته ليتحرّش بـ “هزار” التي استبعدت قصده بادئ الأمر، إذ تقول: “وتحرُّشه بي مرّات عديدة … أبعدتُ وقتها عن تفكيري أنّه من الممكن أن يكون تحرّشهُ مقصودًا، هو في السِّن أصغر من أبي بسنوات، لكنّه يبقى عمّي!” (ن. م.). ولكنّ شهوته الحيوانية أعمته عن قيم المجتمع التي تريد الكاتبة أن تُظهر هشاشتها أمام الوحش الذكوري الذي يتستّر بها. فقد افترس العمّ جسد “هزار”، ابنة أخيه التي تحرّمها عليه كل الأعراف الأرضية والسماوية، ولم يقم وزنا لخصوصية ذلك الجسد وحرمته. تقول: “حاولتُ أن أصرخ “آه”، حين عبثتْ يدُ عمّي بنهديَّ تداعبهما من فوقَ الثّوبَ الأسود، … بنظرة عمّي الشهوانيّة، وحملقته بجسدي بعينيْهِ الجاحظتيْن، وشفتهِ السّفلى الغليظة، وبقامتِهِ الفارعة الّتي أغلقت فمي، وبكفّهِ الشّبقة غامَ الصّوتُ في خوفه … يفكّ أزرار بنطالهِ، مُحاولاً اختراق عذريّة أرملة … بلُهاثِهِ المعقودِ على أنفاسي، وبسائلٍ ساخنٍ مكبوت بصفار الحرمان سالَ بين فخذَيّ الملتصقيْن!” (ص 135). من الواضح أنّ الكاتبة أرادت تعرية المجتمع وفضحه من خلال مثل ذلك التصرّف البهيمي للرجل في المجتمع الذكوري. ولكن، باختيارها شخصا من المحارم، لا شكّ أنّها أرادت أيضا، أن تطرح قضية لا يحتمل مجتمعنا الحديث عنها، هي قضية “سفاح المحارم”، ذلك المرض الاجتماعي الذي يفتك بالمجتمع، ولكنّه يحدث في الخفاء وقلّما نسمع عنه. والكاتبة بذلك لا ترمي فقط إلى الإشارة إلى مرض اجتماعي، وإنّما أرادت أن تعبّر عن خلخلة الواقع في المجتمع الذكوري، بكل قيمه وأعرافه وعلاقاته. وهذا وحده سبب كاف لتمرّد المرأة وثورتها، لأنّها هي أكثر من يدفع ثمن تلك الخلخلة وانهيار قيم المجتمع.
في مواجهة الظلم والقمع، تطرح الكاتبة في روايتها قضايا المرأة العربية الضحيّة بأشكالها المختلفة. فهي مثلا الطفلة، المرفوضة كمولود أصلا، إذ هي مشروعُ عارٍ قادم، يجتمع عليها المرض والإهمال والشعوذة وانغلاق المجتمع وتخلّفه، فتموت غير مأسوف على رحيلها، إلّا من قلّة قليلة جدا من النساء اللواتي لهنّ صلة بمعاناتها سواء كنّ يتمتّعن بقدر من الوعي أو لا. وغالبا ما يكون وعيا صامتا: الأم بدافع أمومتها وخوفها، و”هزار”، الأخت في بدايات وعيها الصامت، حزنت كل منهما لموت “منية”، ولكنّها صمتت. فـ”هزار” مثلا، لم تكن تعي أنّ أختها لم تسقط ضحيّة المرض وحده.
والمرأة هي أيضا الصبية العاشقة، التي يخنق المجتمع عشقها في مهده ويخنقها معه، فإمّا أن تُقتل أو تُرغم على الانتحار إذما لوحظت أيّ ترجمة لذلك العشق في الواقع، حتى لو كانت تلك الترجمة وليدة الوهم، كما حدث لـ “دلال”، أخت البطلة التي دافعت عن كرامتها دفاعا سلبيا بالانتحار. وهو انتحار قسري دفعها إليه ضغط المجتمع المتخلّف. وإمّا أن تُرغم المرأة، الصبية العاشقة أو غيرها، على الزواج ممن لا تُحبّ ولا ترضى به زوجا، وهي عملية توازي النحر والانتحار في آن معا.
وهي أيضا المرأة الشابّة، المطلّقة أو الأرملة. الظاهر في الحالين، أنّ الطلاق أو الموت هزّ كيانها وهدم عالمها، ولكنّ الحقيقة، هي أنّ واقع المجتمع الذكوري المتخلّف الذي أرغمها أصلا على الزواج ممن لا تُحبّ وترغب، هو الذي قام بذلك. والأشدّ صعوبة من ذلك، أنّ المجتمع، في ظرف المرأة الجديد، كأرملة أو مطلّقة، بدل أن يقدّم لها يد العون والدعم، يحاصرها ويُقيّد حركتها، اجتماعيا وجغرافيّاً. في الظاهر ليحافظ عليها من نفسها ومن الطامعين بها، وفي الحقيقة، ليحافظ على قيمه وأعرافه، والأهمّ، على هيمنته الذكورية التي ترفض أيّ دور للمرأة غير الذي يرسمه لها. هذا الحصار يحوّل المرأة إلى أحد نوعين من المارد الذي يخرج من القمقم: الأول، هو المارد الذي يخرج من قمقم المجتمع دون أن يكسّره، ليدخل في قمقمه الشخصي مكتفيا بتلبية احتياجاته الشخصية، ومثاله “أم فراس” قبل لقائها مع “هزار”، فقد كانت تعيش حريتها الشخصية لا تكترث للمجتمع وتقييداته ولكنّها تتفادى المواجهة معه ولا تُحاربه. والمارد الآخر هو المارد الذي يُفجّر القمقم ويرفض حبسه في أيّ قمقم من أيّ نوع، يخرج من قمقمه شاهرا سيفه جاهزا للقتال. ذلك المارد لا تنحصر اهتماماته بحاجاته الشخصية بل يتعدّاها إلى الآخر، المرأة عامة والمجتمع ككل. تلك هي “هزار”، بطلة الرواية، التي كسرت القمقم وفضحت كل محتوياته ونشرت غسيله القذر على السطح. وإذا تفهّمنا تخوّفها وقلقها الطبيعييْن، سنجد أنّها لا تبالي بأيّة ردّة فعل من أيّ نوع، فإذا كان المجتمع يضعها في الهامش، فإنّ تمرّدها يضعها في الصدارة، لتصبح هي المركز وليندحر المجتمع الذكوري بغبائه وجبروته إلى الهامش. فهي التي تقود المجتمع إلى حريته الاجتماعية أولا، وإلى حريته السياسية والوطنية كما سنرى لاحقا.
المرأة / الكاتبة ومباهج الخلاص
يقمع المجتمع الذكوري المرأة ويهمّش دورها في كل مراحل حياتها. مظاهر القمع وممارساته في مجتمع الكاتبة كثيرة، تدفع ثمنها “هزار”، بطلة الرواية، ونساء الرواية الأخريات، في دائرة مجتمعهنّ الضيّقة، والمرأة العربية عامة في دوائر المجتمع الأوسع. ولكن، ما هي مباهج الخلاص التي تحتفي بها الكاتبة وبطلة روايتها، وما هو الثمن الذي تدفعه المرأة لبلوغ تلك المباهج؟
تدفع المرأة ثمن خضوعها وثمن تمرّدها، متفرّقيْن أحيانا ومجتمعيْن أحيانا أخرى. تموت المرأة طفلة بالمرض، وصبية بالانتحار أو غيره، ولا يعبأ بموتها أحد. وإن كُتبت لها الحياة، تعش بلا دور على هامش الحياة، وتُصادر حقوقها فتمنع من الحبّ والاختيار، وتُزوّج قسرا ممن لا تحبّ، ويُهمّش دورها بعد الزواج فتخضع لخدمة زوجها وإملاءاته وإشباع رغباته. وإذا فقدت زوجها بالطلاق أو الموت، تُحاصر وتُفرض عليها إقامة جبرية تخنقها، حيث تُسجَن في البيت خوفا عليها من نفسها ومن الطامعين بجسدها، وخوفا من ثرثرة المجتمع الذي لا يرحم. ورغم قتامة الصورة لا تنفك المرأة تبحث عن خلاصها. ذلك البحث يُفسّر وعيَها بضرورة الخلاص، واستعدادها لدفع ثمن الخلاص ومباهجه. هذا الثمن تختزله الرواية فيما مرّ على “هزار” من أحداث مؤلمة خلّفت جروحا في قلبها ونفسها، إلّا أنّها خلّفت أيضا تجربة ومعرفة وتراكم خبرات أنارت الطريق وحثّت على التمرّد الذي لا خلاص بدونه. وأعطت دفعا وقدرة على المواجهة مع مجتمع أصبحت المرأة المجرّبة فيه تُدرك مواطن ضعفه التي تستطيع أن تنفذ منها. من هنا، تظهر مباهج الخلاص في الرواية بأمرين كلاهما يوحي بالتمرّد: تمرّد الكاتبة بالكتابة، وتمرّد بطلة الرواية على المجتمع وقيمه التي تخنقها، وانتزاعها حريّتها من براثنه.
يظهر تمرّد الكاتبة في إصرارها على الكتابة وفي إيمانها بها كخلاص. بدأت طريقها بكتابة الشعر، أصدرت سبع مجموعات شعرية لم تكن كافية لتحقيق الخلاص لها. فلجأت إلى كتابة الرواية، ما يُعبّر أولا عن إصرارها على الكتابة والخلاص بها، ثم عن إيمانها بأنّ الرواية ستحقّق لها ما عجز الشعر عن تحقيقه، لأنّها ستوفّر لها مساحة أكبر للبوح والفضح اللذيْن يعبّران عن تمرّدها: البوح بما يعتمل في أعماق نفسها، وفضح المجتمع الذي يظلمها كإنسان، ويقمعها ويُهمّش دورها ويقتل إحساسها بأنوثتها كامرأة.
أمّا “هزار”، بطلة الرواية، فهي رسول الكاتبة إلى المجتمع، تتمرّد عليه وعلى أعرافه وقيمه، لتعبّر بذلك عن حاجة المرأة إلى الخلاص الشخصي والجمعي الذي لا يتمّ إلّا بالتجربة وتراكم الخبرة والمعرفة التي تولّد الوعي بضرورة الخلاص. من هنا، يأتي طريق الآلام التي مرّت بها “هزار”، تعبيرا عن تجربة المرأة وتراكم الوعي والمعرفة لديها، ما يُؤهّلها للتحوّل إلى النضال الواعي الذي تتحمّل فيه القمع والعذاب وتدفعهما ثمنا لخلاصها.
في الرواية الكثير مما يُعبّر عن وعي المرأة ونضوجها، وأنّهما لم يكونا مجرّد حلية تزيّن الكاتبة بها صدر روايتها أو صدر بطلتها. فقد تجلّى ذلك بوضوح أولا، في قدرة البطلة على التمرّد وقدرتها على اتخاذ القرار وكسره تبعا للظروف التي تحاول هي خلقها كامرأة تتمرّد على مجتمعها الذي أدركت أنّه لا تُمكن مواجهته إلّا بالتمرّد عليه، وذلك لانغلاقه ورفضه أيّ لغة أخرى للتفاهم. “هزار”، بطلة الرواية، تذهب بقرارها ورجليها إلى بيت “نبيل”، وعندما لم تجده، “عادت أدراجها تحملُ باقة من الحبق، قطفتها من حوض يزيّنُ ساحة المنزل، فقد أحَبَّ“نبيل” الحبق والزّعتر! وضعت قصفة حبق في جيب سترتها ومَشَتْ،وحال لسانها يدندن فرحها الآتي: “سَيَبْقى نبيل لوحدهِ هنا؟ يا للمفاجأة! وسوف نلتقي كما كُنّا؟ لن أتراجع أبدًا ... سأسبقهُ للقاء وسأختار أنا المكان والوقت، ولن أدع الأماكن والأزمان تُعارضني،كما فعلتْ سابقًا، بل سأنْصُبُ ظلّي عندَ المغيب، واستأصل المكان والزّمان، وأسدِلُ عليهما “طرحة الزّفاف“، وأدعها تسافرُ كَمَراكبِ اللّيل في البحر ... نعم، سأسابقُ الغيمَ إليكَ حبيبي، ولو على ظهر موجة!” (ص 98-99). هذا القرار الذي اتخذته “هزار” بإرادتها، هي التي عادت وكسرته بإرادتها أيضا، كما في المقطع التالي: “لم يصدّقْ بأنَّها أسْرَعت نحو باب الغرفة لتفتحهُ!! نظرتْ إليهِ بعينيْنِرماديّتَيْنِ وغادَرَتْ ...! نزلت الدَّرج المؤدّي إلى الشّارع القريب ... وعبرتْ من أمام مَقْهى شهد أوّل لقاء بينهما. لا ... لَنْ تعودَ ... سَوْفَ تُصرُّ على قرارها، وتعلن للشَّجر والشَّمسوالهَواء أن لا تراهُ بعدَ اليوم” (ص 9). وكون القرار جاء في الصفحة الأولى من الفصل الأول فذلك يعني أنّ البطلة، ومن ورائها الكاتبة، تعي تماما ما هي عازمة عليه، ولهذا بدأت الكاتبة روايتها من الوسط، من بلوغها الواثق من وعيها وقدرتها على اتخاذ القرار. أهميّة هذا القرار، الذي يُمثل مرحلة أو مفصلا بالغ الأهمية في حياتها، هو ما دفعها لاتخاذه حاملا للسرد كما سأبيّن لاحقا في حديثي عن الشكل الفنّي للرواية. المقطعان السابقان يُؤكّدان على إصرار “هزار” على إبداع تصرّفها بنفسها وإرادتها هي، اعتمادها على ذاتها في تحقيق ذاتها. وهذا هو واحد من أهداف “هزار” كما هو واحد من أهداف الكاتبة، أن تبلغ المرأة العربية هذه المرحلة من التحرّر وتقرير المصير.
وقد أعلنت “هزار” ومن خلفها الكاتبة، تمرّدها في مواضع أخرى كثيرة من الرواية. مثلا، في استمرارها بحب “نبيل” العائد الذي أحبّته قبل زواجها قسرا قبل عشرين عاما. تقول “هزار” بنبرة ملؤها التحدّي والإصرار على التمرّد: “سأنتزعُ “نبيل” من ضلوعي، كانتزاعي “طرحة الزّفاف” من تحت التّينة،وسأزرعهُ في مكانٍ أعمق في تلافيف الشّريان، وسأزرعُهُكما زرعَ أبي في جسدي كراهيّتيلأوّل رجلٍ اغتال كبريائي” (ص 93). وتتمرّد في استقبالها لحبيبها، “نبيل”، وارتمائها على صدره في بيتها، ضاربة بالأعراف والتقاليد عرض الحائط، فقد “سقطت كلّ الأقنعة! سقطتْ بعدما تيقّنت “هزار”، أنَّ الّذي يحطّ على مفصل القلب هو “نبيل”، ولم يكن هناكَ غيرهُ، فهو حبُّها الوحيد وسيّدها الوحيد” (ص 101)، سيّدها الذي ترى في عبوديتها له قمّة الحرية لأنّه اخيارها لعبودية الحبّ المشتهاة التي تختارها المرأة بمحض إرادتها. ذلك لم يمنعها من إظهار حذرها وخوفها المشروعيْن مما قد يسبّبه ذلك اللقاء. تمرّدت كذلك في ذهابها إليه في بيته في المدينة، “لملَمَتْ الشّظايا من تردّدها بالذّهاب إليهِ … تريدهُ هذا المساء، وهي على أتمّ الاستعداد للقائِهِ … أيّ الفَساتين ترتدي؟ أيّ عقد تُزيّنُ بِهِ عُنُقَها؟ بأيّ عطر تتعطّر؟ لا بدّ أنّها ستكون مُدهِشة!” (ص 104). وقد بدأ تمرّدها قبل عودة “نبيل”، وذلك في لقائها بـ “أدهم” وممارسة الجنس معه أكثر من مرّة، في المدينة أيضا، المدينة التي تحمل دلالات مختلفة، سأتحدّث عنها لاحقا.
في الرواية أيضا، يبرز التجلّي الآخر لوعي المرأة ونضوجها، في قدرتها على الكتابة. وقد بلغ نضوج هيام قبلان ككاتبة، مرحلة متقدّمة باختيارها هذا الجنس الأدبي المعقّد، الرواية، مجالا للكتابة، بعد مطارحة الشعر لسنوات طويلة. ويتجلّى نضوجها أيضا، فيما أبدته في روايتها، “رائحة الزمن العاري”، من وعي لظروف مجتمعها وتحوّلاته، ووعيها لظروف المرأة وتحوّلاتها فيه، وبالتالي وعيها لظروفها الشخصية وتحوّلاتها هي أيضا. تلك التحوّلات، بتوافقها وتناقضها، خلقت لديها جرأة غير متوقعة، وغير مسبوقة إذما قيست بظروف مجتمعها، المجتمع العربي في إسرائيل عامة، ومجتمع الطائفة العربية الدرزية المحافظة بشكل خاص. وقد ظهرت تلك الجرأة جليّة في تفكيك هيام قبلان للبنى الاجتماعية وتعريتها للعلاقات السياسية القائمة على العمالة والسمسرة، وكذلك في خرقها للمحظورات على مستوى السياسة والجنس.
الأمّ ودورها في خلق مجتمع حُرّ
هناك دوران أساسيان للمرأة في خلق مجتمع جديد حُرّ، نستشفّهما من الرواية في دورين أساسيّين وهامّيْن في حياة “هزار” ومعاناتها. الأول هو دور الأمّ، أمّا الثاني فهو الدور الوطني الذي تنطلق فيه الكاتبة من تماهي اغتصاب الوطن مع اغتصاب المرأة، ومن أنّ تهاون الرجل بحقّ المرأة ومكانتها الذي يقوده إلى التهاون بحقّ الوطن وحرية شعبه. الدور الثاني هو موضوع حديث لاحق.
دور الأم جسّدته الكاتبة بشكلين ومرحلتين مختلفتين: أمومة أمّ “هزار” لها، وأمومة “هزار” نفسها لابنتها. لم تُطل الكاتبة الوقوف عند الأمومة الأولى، فقد اكتفت بتصوير ضعف الأمّ التي كانت أعجز من أن تحمي بناتها من الظلم الواقع عليها وعليهنّ، وقد أذعنت لعبوديتها الصامتة لزوجها ورضاها الخانع بدور “النعجة” كما كان يحلو له أن يناديها. تلك الوقفة القصيرة مع الأمّ الضعيفة الخانعة الخاضعة لما يرسمه الزوج ومجتمعه الذكوري لها كزوجة وكأمّ، تعني أنّ هذه المرحلة هي ماضٍ انتهى وكان لا بدّ له أن ينتهي. برز ذلك في موت الأم وخروجها من حياة “هزار” بعد أن تركت معاناتُها آثارَها المرعبة في نفس “هزار” وحياتها. ولكنّها تركت آثارا إيجابية أيضا. فقد كان ضعف الأمّ وخضوعها هو السبب الأول في زرع بذرة الوعي والتمرّد في أعماق “هزار”. وقد كلّفها النموّ البطيء لتلك البذرة، ثمنا باهظا فيما بعد. وهو ذاته ما جعل “هزار”، لاحقا، أمّاً مختلفة. لهذا السبب نرى أنّ الكاتبة أبدت اهتماما أكبر بالمرحلة الثانية، مرحلة أمومة “هزار” لابنتها “سمر”. بتلك المرحلة أثبتت الكاتبة وبطلة روايتها أنّ المرأة قادرة على الوقوف على رجليها وتحمّل مسؤوليّاتها وتدبّر أمور حياتها بدون الحاجة إلى رجل لا يعبأ إلّا بجسدها وقدرته على إشباع رغباته. وهي قادرة أيضا على رسم مستقبلها الذي تريده مغايرا لما يريده مجتمعها الذكوري المتخلّف. ولذلك، ليس عبثا دفعت “هزار” بابنتها إلى الجامعة، وإنّما عيا منها بدور الثقافة في حياة المرأة الباحثة عن حريّتها. ولهذا فقد رسمت الكاتبة “هزار” أمّا مثقّفة واعية، ورسمت “سمر” ابنة “هزار” طالبة جامعية تُمثّل المستقبل المتسلّح بقوة الوعي والمعرفة. المستقبل هو الأهمّ، ولذلك تنبع أهمية الماضي من خلال توظيفه لبناء المستقبل. ولذلك أيضا، كانت مرحلة الأمومة الأولى قصيرة، وماضيا انتهى، تكمن أهميته في كونه نقطة انطلاق “هزار” من الماضي إلى الحاضر، ثم انطلاقها إلى المستقبل بكل ما يحمله من تضحية وألم وأمل، ذلك المستقبل الذي تمثّله “سمر”، والذي لا بدّ من ارتكازه على الحرية والمعرفة والحبّ. ولذلك فهو يحتاج إلى التضحية والتفاني في العطاء. لقد استقت “هزار” قوتها من ضعف أمّها، واستلهمت تمرّد الحاضر ونور المستقبل من ظلام الماضي، ما دفعها إلى تنشئة ابنتها، “سمر”، بأسلوب آخر مختلف، أسلوب يتلاءم مع متطلّبات المستقبل الذي يحتاج إلى امرأة حرّة واعية. وأمّا قلق “هزار” كأمّ على ابنتها، والذي يبدو واضحا في الرواية، ما هو إلّا شعور إنساني طبيعي نحو المستقبل الغامض الذي نريده أن يكون أجمل، لذلك فهو عادة يحتاج إلى الكثير من المواجهة والتضحيات، والحذر من العوائق والعثرات. ولذلك ينتج عنه الكثير من القلق والألم. يظهر قلق الحاضر وغموض المستقبل بشكل واضح حين تقول “هزار” مناجية ابنتها “سمر” الغائبة: “أشتاق إليك … أمدّ يدي، وأصابعي تلامس وسادتك الخالية، وغطاء السرير الملقى على الكنبة صارخاً ينتظر رجوعك، وجسدي ينتفض كلما لمحت ثوب نومك الوردي المعلق قرب السرير!” (ص 156). “هزار” تضحّي من أجل ابنتها وليس من أجل نفسها فقط، وبما أنّ ابنتها تمثُل المستقبل، فذلك يعني أنّها تضحّي من أجل مستقبل المرأة عامة، وأنّ دافعها الأهمّ هو الهمّ الجمعي وليس الفردي. تضحّي وهي تعي أنّه لكي يكون المستقبل ورديّا، فلا بدّ له من طريق آلامه الخاصة.
خرق المحظور الاجتماعي وتوظيف الجنس
“مبارك لنا هذا الرّباط المقدّس يا زوجتي الحبيبة! دونَ مأذون ودونَ كاهن أو أوراق! فقط قليل من نبيذ الآلهة نحتسيه حبًّا، دون ترتيل في كنيسة، ولا زغرودة في زفّة، ودون راقصة على بابِ الفرح! فقط، وفقط أجراس قلبيْنا تقرع جسدَيْنا بروحَيْنا، فتُطوّبُنا بالحبِّ الأزليّ!” (ص 180).
لم ألحظ أيّ ذكر للدين في الرواية غير ما تقدّم في الفقرة السابقة. لذا، لا أعتبره خرقا للمحظور الديني بقدر ما هو تعبير عن الحرية. ربما كان هنالك أكثر من سبب دفع بالكاتبة إلى عدم المواجهة مع الموروث الديني ورموزه. وأنا، إذ أحترم موقفها، لا أرى حاجة لانشغال هذه الدراسة بتلك الأسباب، ما دامت الكاتبة قد أهملت هذا الجانب ولم ترَ فيه عائقا أمام ثورتها وتحقيق طموحاتها. المشكلة الحقيقية، كما أتخيّلها في ذهن الكاتبة، ليست في الموروث الديني أو رموزه، إنّها في الموروث الاجتماعي الثقيل وما فيه من قيم وأعراف بالية ورموز ذكورية، تجثم كلها على صدر الكاتبة وعلى صدور نساء مجتمعها عامة. ومن خلال ذلك الموروث ورموزه فقط، يخترق شبح السياسة جدران مجتمعها الهشّ ليساهم في خنقها وتهميش دورها. ولذلك، لم تتورّع الكاتبة في خضمّ ثورتها وتمرّدها، من خرق المحظور الاجتماعي بجرأة غير متوقّعة، مستعينة لذلك بتوظيفها الجريء للجنس في روايتها.
كما أنّ للجنس حاجته ونكهته الخاصة في حياة الإنسان، جعلت الكاتبة لخرق تابو الجنس في روايتها نكهته الخاصة أيضا، سواء كان ذلك في اللغة المباشرة أحيانا أو المثيرة برمزيّتها وكثافتها أحيانا أخرى، أو في وعيها له بإبعاده المختلفة: كونه حاجة جسدية مشروعة، أو كونه رمزا يحيل إلى الحرية والتمرّد، أو أداة لفضح المجتمع والانتقام منه، أو تقنيّة فنية تُثري جمالية الرواية شكلا ومضمونا. وعند تتبّعنا للرواية وما فيها من مشاهد الجنس، نجد أنّ الكاتبة خرقته بجرأة غير متوقّعة وبتحدّ غير مسبوق، سواء كان ذلك بشكل عام في دائرتها الكبرى التي تحتويها وتُؤثر عليها، الأقليّة العربية في إسرائيل، بغضّ النظر عن شكل الاحتواء والتأثير، وبغضّ النظر أيضا عن شكل القبول والرفض لذلك الاحتواء والتأثير، أو في دائرتها الصغرى، الطائفة العربية الدرزية، الطائفة المحافظة أكثر من غيرها في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث التحدّي والجرأة كانا خارقيْن بشكل خاص. ولا أخفي على القارئ أنّ في الأمر شيئا من الإرباك لناقد يتلمّس طريقه في المجتمع ذاته، إذ يُحاول جاهدا مقابلة جرأة الكاتبة في النص بجرأة تُماثلها في النقد، جرأة لا بدّ من بلوغها لكيلا يظلّ نقد النص وكاتبته ناقصا.
تتبّع مشاهد الجنس في الرواية يثبت أنّ الكاتبة خرقت تابو الجنس ليس كرمز للحرية أو تعبيرا عنها فقط، وإنّما للأسباب السالف ذكرها مجتمعة أو متفرّقة. خرقته أولا للجنس ذاته، لأنّها تريد أنّ ترسّخ في وعي مجتمعها أنّ الجنس حاجة جسدية مشروعة، للمرأة كما هي للرجل، حاجة تُساهم في ربط أواصر المجتمع وتكامله الفردي والجمعي بأبعاده المختلفة. ولذلك فقد اهتمّت باختيار شخصياتها ومشاهدها الجنسية بحيث تكون بعيدة عن أجواء الدعارة والانفلات، وقد استعانت بالتصريح المعتدل أحيانا وبكثافة اللغة غالبا. وقد أقلّت في استخدامها للغة المباشرة، كتعبير عن رفضها لمثل تلك الأجواء. اهتمّت أيضا بأن يكون الجنس الذي تبحث عنه وتقدّسه لذاته وتنوي ترسيخه في وعي المجتمع، هو ذلك الجنس الذي تلتقي فيه الأرواح بالأرواح كما تلتقي الأجساد بالأجساد، ويكون فيه اللقاء الجسدي ثمرة للقاء الروحي، بعيدا كل البعد عن الدعارة والابتذال. أمّا الجنس الذي تلتقي فيه الأجساد بدون لقاء روحي، فهو ما جعل الكاتبة تنظر نظرة دونية إلى الجنس كحاجة جسدية فقط، حتى عندما تمارسه “هزار”، بطلة روايتها التي تتماهى معها وتعبّر عن أفكارها.
عرضت الكاتبة لبطلة روايتها مشاهد لممارسات جنسية مشروعة وأخرى غير مشروعة، ممارسات مرغوبة وأخرى مرفوضة، لكي تصل في النهاية إلى تثبيت الحالة المشروعة التي ترغب بها وتريد ترسيخها في وعي المجتمع. وذلك من خلال علاقة “هزار” و”نبيل”، حيث أبرزت الكاتبة الجنس كحاجة جسدية مشروعة ومرغوبة لأنّها غير خاضعة لنداءات الجسد فقط، بل تتحكم بها نداءات الروح قبل الجسد، لأنّ “نبيل” هو الحبيب الذي تهفو إلى وصاله روحها قبل جسدها، وتُحبّ وصاله الجسدي أن يكون ثمرة لوصالهما الروحيّ، كما في الفقرة التالية:
“بعد أن علّقَ نبيل لوحتين دوّن عليهما اسم “هزار”، حضَّر القهوة كما كانت تتخيّل، فلم تكن في الغرفة كؤوس نبيذ وفودكا، إنّما رائحة القهوة وأريج الأقحوان! امتدّت أصابعه تلامسُ خصلاتِ شعرها، وترفرفُ فوق خَدَيْها بملمسٍ من حرير، وإلى شفتيها تمتدّ شفتاه، ثمّ ترسم قبلة فوق جبينها … استسلمت بكلّ جوارحها، متناسيةً “نزار” و”سمر” وجارتها “أُمّ فراس”! بين يديه هي الآن، وحدهما ولحظة أزليّة كم انتظرها عمرُها كلّهُ، فكيف تبخل بها عليهما؟! تلوّنت يداه بلمساتها المتصاعدة لهيبًا في أنحاء جسدها، إلى وجنتيها … عنقها … صدرها … خاصرتها … ليتأجّج بالرّغبة، ويغدو شعلة نار تتشهّى، وتزيل ستار الخجل المسدل على لوحة جسدها المتحفّز للاحتراق!
– “نبيل” أحبّك … لكنّني لا أستطيع الآن، أرجوك ليسَ هنا … بل أريدُ لهذه اللّيلة أن تكونَ بشكلٍ آخر، وفي مكانٍ آخر، أريدُها مميّزة بغرابة تفاصيلها الخاصّة.
– كما تريدين … بعد عشرين عامًا من الغياب، سيكون حُلْمُنا دائم الحلمِ باخضراره” (ص 109-110).
في الفقرة السابقة يبدو واضحا أنّه لا مكان للقاء الجسدي خارج الحضور الروحي. كما يبدو أيضا، أنّ خرق تابو الجنس جاء كتعبير عن الحرية، إذ “هزار” هي التي ذهبت لـ “نبيل” بإرادتها، وهي التي قطعت الممارسة الجنسية، لا لرفضها لها، وإنّما لأنّها تريد لها شكلا آخر ومكانا آخر، فيهما تعبير عن حريّتها وحبّها وسعادتها. كما أنّه يبدو واضحا توظيف الكاتبة للجنس كتقنيّة تُضفي على الرواية بعدا جماليا أيضا، إذ تحافظ الكاتبة على نكهة الجنس وروحانيته ورومانسية أطرافه، وذلك في كثافة اللغة ومحدودية الألفاظ وبعدها عن الابتذال.
وفي نموذج آخر، تُوظّف الكاتبة الجنس كحاجة جسدية مشروعة ولكن مرفوضة: مشروعة، حيث الجنس تجسيد لشرعية الحاجة إليه، وتعبير عن الحرية أيضا. ومرفوضة، لأنّها تقوم على إشباع حاجات الجسد فقط، بعيدا عن حاجات الروح، وتترك نتائج تزعزع كيان المرأة وتورثها جروحا لا تندمل. تقول “هزار”: “كيف لي نسيان الجرح مع أدهم، ونزفه لا زال ينتفض في الحنايا؟” (ص 74).
في لقاءات “هزار” و”أدهم”، عبّرت الكاتبة عن الجنس كحاجة جسدية مشروعة عبّرت به عن الحرية والتمرّد. “هي من أرادت أن تكون برفقة أدهم … لم تلتقِ برجل يروي ظمأها منذ أمد” (ص 78)، فقد ذهب “هزار” بإرادتها إلى “أدهم” في العنوان الذي حدّده، وهناك قال لها: “إنّنا وحدنا هنا، ومن حقّنا تفريغ مشاعرنا … (فَ) تلاقت الشّفاه … تمازجت الأنفاسُ … تراقصت الأصابعُ، ولم تشعُر إلاّ وهي شِبه عارية” (ص 79-80). وبإرادتها قطعت اللقاء أيضا، خاصة عندما أدركت أنّ “أدهم” ككل الرجال، “كل الرجال هكذا يفكّرون بالمرأة كجسد … أدهم يريد جسدها متمرّغا بكأس نبيذ وسيجارة” (ص 80-81). قالت: “لا يا أدهم … أرجوك، لم أفكّر بعلاقتي معك بهذه الطّريقة … دعني أغادر … (و) نزلت الدّرج إلى الشّارع دون اعتذار” (ص 80). في اللقاء الأخير مع “أدهم”، مارست “هزار” الجنس بدافع الحاجة والحرمان، وكذلك بدافع “الإحساس بالحرية المحاصرة … بالمغامرة والتمرّد” (ص 84)، في ذلك اللقاء “رأت نشوة في عينيْهِ (أدهم) غابتعنها عمرًا؛ نشوة الشّباب الضّائع، وفي شفتيهِ رجفة ظمآى! أحسّت بصخب أنفاسِهِيلفّ وجهها، ويعانِقها ... لمْ يعد لونُ ثوبها أرجوانيًّا،وفِكرُها تعرّى خلال لحظات، فشَهقت السّتائِر،وضجّ الجسدُ برغبة تتوحّش، وتتمطّى الشّهوة على سرير الحرمان، وكؤوس النّبيذ الفارغة بحياء تسترق النّظر، وتعود تحملقُ في جدران الغرفة، والسّتائر المخمليّةحدّ الشّهقة الحالمة، تجازف في احتضان نور شمعة مضاءة باشتعال الفضاء في الرّكن! التحمَ الجسدان … التصق بها، مداعِبًا سواحل بحرها” (ص 84-85). لغة المشهد رغم كثافتها العالية، تُؤكّد تُبيّن الحاجة الشخصية أيضا، كما في: “وضجّ الجسدُ برغبة تتوحّش، وتتمطّى الشّهوة على سرير الحرمان”. وقد سبق هذا المشهد ما يُؤكّد إصرار “هزار” على الانتقام من المجتمع المتمثل بأخيها “نزار”، المجتمع الذكوري الذي يحلّل للرجل كل شيء ويحرم المرأة من أبسط حقوقها. تقول “هزار”: “إنَّه الإحساس بالحرّيّةالمحاصَرَة ... بالمغامرة وربّما بالتّمرُّد ... لا تَدري ... وماذا عن “نزار” إن علمَ بالأمر؟ فهو دائم التّواجدفي المدينة،وهوَ ابن الشّوارع والحاراتوالحانات والغرف المنسيّة” (ص 84). تقول “لا تدري”، والحقيقة أنّها تدري أنّها تريد الحرية وتريد ممارسة الجنس كحقّ وحاجة مشروعيْن، وتريد الانتقام من المجتمع الذي يمثّله أخوها “ابن الشّوارعوالحارات والحاناتوالغرف المنسيّة”، لأنّ القلق والتخوّف اللذين في التساؤل “وماذا عن “نزار” إن علمَ بالأمر؟”، لا يمنعانها عن متابعة طريقها إلى غرفة “أدهم” وممارسة الجنس معه. في حديثي عن اللغة، سأوسّع الحديث عن كثافة اللغة وجماليتها.
في النموذج التالي لتوظيف الجنس وخرقه كتابو اجتماعي، تعبّر الكاتبة عن أمراض المجتمع ورفضها لتربيته وسلوكه الذكوري، بواسطة توظيف الجنس كحاجة مرفوضة قطعا وغير مرغوب بها تماما، لأنّها تنتهك خصوصية المرأة وتهدر كرامتها. وفيها أيضا تكريس لضعفها، خاصة أثناء معاناتها الحرمان الجنسي في بعض أوضاعها الاجتماعية كأن تكون مطلّقة أو أرملة شابة لم تؤخذ حقّها وحاجتها من الجنس. ذلك هو مشهد انقضاض “الجَنّان” على “هزار” في بيتها، أثناء وجودها عارية في “الحمّام”:
“نعم، لا زالت تذكر حين استدعته للاعتناء بالحديقة منذ عاميْن، حين نسيَ حديقة البيت ليعبث بحديقة أنثى! باغَتَها في الحمّام عند اغتسالها، فارتطمَ رأسُها بجدران الحّمام، وهي تقاوم عينيْن تقدحان بشهوة عارمة، ولُعابًا يسيل رغبة حارقة على جَسدها … هذا الوحش المتصبّب عرقا ولهاثا، بكفّيْه الغليظتيْن احتوى نهديْها يمتصّ العنّاب بشفتيْن نهمتيْن، وتناثرَت صرخةُ جسَدِها في فقاعات الصّابون! استغاثت بالنّافذةِ، بالعطر، بستائرِ الحمّام، بالصّابون، بثيابها الملقاة على الأرضِ، بدموعها … استنجدتْ بخجل خوفها من الفضيحة، وبأسنانها الّتي اصطكَّت وارتجفت، فترنّحَ الجسدُ مقاوِمًا … وتحتَ وطأة جسدِهِ الشّبابيّ المفتولِ فقدتْ أنفاسها، وخارتْ قواها الفتيّة في أتون غضبِهِ الشّرس: – “أريُدكِ، إنّكِ بحاجة لرجلٍ مثلي … أشتَهيكِ أيتها السَّاقطة! سأسْحَقكِ أيَّتها الزّانية” (ص 35-36).
في المشهد المذكور أعلاه، تصوير لمحاولة اغتصاب تُنتهك فيها حرمة بيت “هزار” وخصوصية جسدها، تُظهر فيها الكاتبة ضعف المرأة أمام داخلها المحروم وأمام الخارج الذكوري الذي يفكر دائما بامتلاك جسدها وتسخيره دمية لمتعته. سبق لي شرح الأسباب التي دفعت الكاتبة لإفشال المحاولة. وقد أفلحت بتوظيف المحاولة وخاصة في انتقاء لحظة الإفشال وأسلوبها البسيط الذي يُعبّر عن حقارة ذلك النوع من الجنس وهشاشة العلاقة التي تقوم عليه.
تبلغ الكاتبة ذروة خرق المحظور الجنسي، في توظيف العلاقة المثلية بين “هزار” وجارتها “أم فراس”. فعلت الكاتبة ذلك بكثير من التواضع وربما التحفّظ. تتعدّد أهداف الكاتبة من توظيف تلك العلاقة، وتترك دافعها الحقيقي غير واضح، ربما لاستفزاز القارئ أو الرجل عامة وحضّه على استخلاص الدوافع بنفسه.
يُحيل المشهد المثلي إلى قدرة المرأة على تلبية حاجاتها: الجسدية وغير الجسدية، بدون الحاجة للرجل. لهذا مهّدت الكاتبة باختيارها لشخصية “أم فراس”، الأرملة التي تدبّرت أمورها الشخصية والعائلية بعد موت زوجها. وتُحيل العلاقة المثلية إلى الحرية أيضا. فللمرأة كما للرجل، حريتها في الاختيار وحقّها بتقرير مصيرها بنفسها. كما أنّ المشهد المثلي يُحيل إلى انتقام البطلة والكاتبة من المجتمع الذكوري الذي يعتبرها قاصرة.
في الوقت الذي يحرمها المجتمع من وصال الرجل الذي تحبّ، وجدت “هزار” في صداقة جارتها الأرملة، “أم فراس”، وفي حضنها، شيئا من الهدوء النفسي والأمان الذي لم تجده في حضن رجل، وقد استعادت كل منهما ثقتها بنفسها وبجسدها بعد أن كانت لا تعرفه، بل وصارت البطلة تكرهه إذ تقول: “لم يُعلّمْني أحد أن أتقبَّل جسدي، ولا أن أحبّهُ، فقد كرهتهُ وأنا طفلة، وماتتِ الطّفلة التي بي، حينَ امتدّت إلى جسدي اليد الأولى، لتعبث بأعضائي دونَ رغبة منّي، وازددتُ رفضًا ولم أكن أحبّ أن يلمسني “كريم” (زوجها الذي زُوّجت منه بالإكراه)! كرهتُ جسدي حين لَمَسَ جِلدي البُستانيّ، وندمتُ لأنَّ “أدهم” اغتالَ جسدي برَغبتِهِ المؤقّتة! … ولا يمكنني أن أنسى عمّي …” (ص 134). وقد يكون اللجوء إلى العلاقة المثلية، لأنّ البطلة، ومن ورائها الكاتبة، لم تجد في الفكر الشرقي أو في ثقافة مجتمعها، ما يُشجّعها على التعرّف على جسدها. أمها لم تفعل، وأبوها “كان يتعامل (معها) بمفهوم عقليّتهِ الذّكوريّة المتداعية، وبكبريائِهِ الرّجوليّ، وكان يُحرّمُ على نفسهِ احتضانَ بناتهِ!” (ص 132)، وباقي الرجال في مجتمعها الذكوري امتدّت أيديهم إلى جسدها لتفترس أنوثته، لا لتشعره بكيانه. تقول: “لَم أصادف رجلاً يمكنهُ الإصغاء دون لفْظِ زبدِهِ على سخونة رملي! كلُّ من صادفتُهم عبثوا بأعضائي دون احتوائها” (ص 139). بلغت الكاتبة ذلك المشهد ودلالاته المذكورة، عبر تقمّص البطلة للثقافة الغربية. قد تكون البطلة، والكاتبة من ورائها، محقّة في كثير مما تقول، ولكنّ ذلك لا يُبرّر لجوءها إلى الثقافة الغربية كحلّ لمشاكلها ومشاكل مجتمعها. لم يكن الغرب سببا في كوننا مجتمعا أبويّا ذكوريّا يضطهد المرأة، ولكنه دفع بكل إمكانياته لبقائنا على ما نحن عليه، وقد استغلّنا أبشع استغلال. هل نسيت الكاتبة سياسة “فرّق تسد” التي بدأتها بريطانيا واستمرّت بها حكومات إسرائيل التي اغتصبت الأرض والوطن والإنسان؟ أليس الفكر الإسرائيلي الذي ترفضه الكاتبة، هو نتاج الفكر الغربي وامتدادا له؟ كما أنّ المجتمع الغربي، باعتراف الكثيرات من باحثات الغرب وكاتباته، هو مجتمع أبوي ذكوري أيضا، يقمع المرأة ويُقيّد شخصيتها بالرجل، ويسلبها الكثير من حقوقها، كما سأبيّن لاحقا. وإذا تعمّقت هيام قبلان قراءة الكاتبة الغريبة التي استعانت بها، بل ويكفي أن تتعمّق قراءة العبارة التي اقتبستها من “كاترين” بطلة الرواية الغربية (ص 130-131)، ستجد أنّ “كاترين”، ومن ورائها كاتبة الرواية، فعلت ما فعلته، رفضا ونقدا للمجتمع الغربي الذكوري، صاحب “المفهوم الخاطئ” حول الجسد، بلغة هيام قبلان المقتبسة بعد ترجمتها عن الإنجليزية أو غيرها. تقول “كاترين” في الرواية الغربية، كما جاء على لسان “هزار” بطلة رواية هيام قبلان: “لم أكن مستعدّة أن أتحدّث عن هذه الكارثة، بل لازمتُ الصّمت مثلما تفعل الأرامل عند فقدان أزواجهنَّ! قرّرتُ أن أصمتَ كي أُمارسَ “لعبة الجسد”، ليس بمفهومهم الخاطئ” (ص 130). اعتقد أنّ الكاتبة الغربية كما افهم الاقتباس، اتخذت من الصمت تقنيّة للخلاص من المجتمع الذكوري صاحب المفهوم الخاطئ حول جسد المرأة.
لجأت “هزار” إلى الثقافة الغربية متمثلة برواية لكاتبة غربية (“أعشق جسدي” لتسيبي جون غروس، بحثتُ عنهما في الشبكة فلم أجدهما). “كاترين”، بطلة الرواية، أرملة شابّة مات زوجها في حادث طائرة، تقول: “لم أكن مستعدّة أن أتحدّث عن هذه الكارثة، بل لازمتُ الصّمت مثلما تفعل الأرامل عند فقدان أزواجهنَّ! قرّرتُ أن أصمتَ كي أُمارسَ “لعبة الجسد”، ليس بمفهومهم الخاطئ، فللجسد مكانٌ وزمان لم أعْلَمْه مِن قبل، بالرّغم من إنجابي ثلاثة أبناء! قرّرتُ أن لا أتحوّل إلى أُنثى مسكينة ومكتئبة، ولم استسلم للنّعاس كما تفعل النّعاج بعد أن تَلِدْنَ! كنتُ أحسّ بحاجة لتغيير وقلْب شيء ما … بحاجة أن ألدَ هذه المرّة إنتاجًا جديدًا، وأن أجعلَ معنىً لحياتي، وأنْ أَلِدَ ذاتي مرّة أُخرى!” (ص 130-131). الكتاب شغل تفكير “هزار” وحيّرها، بدليل تساؤلاتها: “هل كاترين أحبّت جَسَدها إلى هذا الحدّ؟ وكيْفَ فعلت هذا؟” (ص 134). “هل أتقبّل جسدَي كما هوَ، أم أفارقه لغير رجعة، أم أبقى في دوّامة الذّاكرة والعتب الثّقيل؟ كيفَ سأحبُّ جسدي وأحتويه وأعانقه؟ كيفَ سأقف أمام المرآة لأتفحّصهُ، وهو الّذي رافقني كظلّي؟ ماذا أحبُّ فيه؟” (ص135-136). ولكنّها للأسف، كالغريق أمسك بقارب النجاة، الثقافة الغربية، متمثّلة أيضا باللغة الإنجليزية التي كانت تكرهها عندما درستها في الجامعة. “كم كرهتُ اللّغة الإنجليزيّة، لأنَّها كانت تُسرِّب إِلى رأسي طنينًا غريبًا لا يمتُّ لحضارتي بِصِلَةٍ” (ص 143)، ثمّ صارت تحبّها، تقول: “َأدري كَمْ هذهِ اللّغة واسعة بمساحاتها كالبحرِ، وكم نستطيع التّعلُّم من الغَربِ، وكم أستطيع أن أَتعلَّمُ من “كاترين” (ص 143). حسب رأيها، وجدت في الكتاب الذي يرمز للثقافة الغربية، ضالّتها، نظريات يُمكن أن تنقذها فراحت تُحاول تطبيقها، جاهلة أو متجاهلة أنّ التعلّم من الغرب ليس معناه أن نعتنق فكره ونطبّقه. وهي تفعل ذلك دون أن تلتفت إلى أنّ الإنسان في المجتمع الغربي، حرّر نفسه بنفسه من خلال المواجهة المباشرة مع السلطة، وليس من خلال النظريات، وأنّ المرأة الغربية ناضلت وأقامت الحركات النسائية التي واجهت مجتمعها الذي لا يقلّ أبويّة وذكورية عن مجتمعنا، وهذا رأي بعض الباحثات الغربيات، كما ذكرت سابقا، وليس رأيي. مثلا، “اتَّهمَتْ “فرجينيا وولف” العالم الغربي بأنَّه مجتمعٌ “أبويّ” منع المرأة من طموحاتها الفنيّة والأدبية إضافة إلى حرمانها اقتصاديا وثقافيا”،[4]… أمّا “سيمون دي بوفوار” فترى أنّ هوية المرأة (في المجتمع الغربي) تنبع دائما من ارتباط المرأة بالرجل فتصبح المرأة آخر (موضوعا ومادة) يتّسم بالسلبية بينما يكون الرجل ذاتا سمتها الهيمنة والرفعة والأهمية”.[5] هل يختلف ذلك كثيرا عن تصرفات “نزار” كممثل للمجتمع الذكوري الذي تعيش فيه الكاتبة وبطلتها؟ قد أحسنت الكاتبة باستعمالها لفظة “ربما” على لسان البطلة عندما قالت: “ربّما أتقمّصُ شخصيّة “كاترين”؟ (ص 143)، و”ربما” تفيد التقليل، وبذلك أبقت بعض الأمل ألّا تفعل. ولكنّ البطلة، للأسف، سرعان ما أفلتت من قبضة الكاتبة، وتجاهلت تلك اللفظة كأنّها لم تكن، وراحت تطبّق النظرية على نفسها وعلى غيرها.
بدأت “هزار” بنفسها، وهذا يعني أنّها تقمّصت الثقافة الغربية، فراحت تقف أمام المرآة تنظر إلى جسدها وتتعرّف عليه، ليس كأعضاء متناثرة، وإنّما ككل واحد. ولكنّ التطبيق الفردي لا يعني أنّ النظرية تلائمنا جميعا. ومع ذلك، راحت تطبّقها على “أم فراس”، ولم تلتفت لما قالته حين عرضت عليها الفكرة: “خُذيني على قَدْ عقلي يا “هزار”. ما يُلائِم الغرب لا يلائِمنا، فتخيّلي نفسكِ وأنتِ تعبثينَ بجَسدِ شخصٍ آخر (هذه العبارة الأخيرة، كبيرة على “أمّ فراس” لغة ومعنى). منذ توفّي “أبو فراس”، لم أنظر إلى نفسي حتّى في المرآة، فربّيتُ الأولاد وزوّجتهم، ولا زلتُ أشرب وأَمْلأُ معدتي الخاوية، وأَشمُّ الهواءَ وأعيش!” (ص 147). ولكنّ “هزار” احتالت على “أم فراس” وداعبت جسدها، لتشبع غريزتها هي، وقد اعترفت سلفا بشوقها لذلك: “كم أَحسُّ أَنَّني بحاجة الآن لرؤية ثوبِ نومها الشَّفّاف، يُخايلُ من تحتِهِ ملابسها الدّاخليّة الّتي تُظْهِرُ فتنة امرأة! يُلامسُ ثوبُها الْخَصْرَ والنَّهْدَيْنِ، ويلتوي عند الرُّكبتيْن، عندما تلفُّ “أمّ فراس” ساقها الواحدة فوق الأُخْرى … راودتها أفكارٌ مخيفة … هل سَتَمتدُّ يداها لتلامسَ ما تحت ذلك الثّوب؟ هل تُجرّب “أمّ فراس” ملامسة الجسد دون التّوقُّف عند أَيّ عضو فيه؟! … كالفراشة طارت إلى بيت “أم فراس”. (ص 144-145). تظلّ هذه الأفكار أقرب إلى أفكار امرأة محرومة من الرجل لأنّها فقدته، أو لأنّها تكرهه لأسباب قد نتفهّمها، أو كلاهما معا، ولكنّها ليست أفكار امرأة تكره جسدها أو تجهله وتحتاج إلى من يعرّفها عليه. لاوعيها فقط هو الذي يتكلم، فحرمانها هو الذي يولّد إحساسها بجسدها، وهي ليست بحاجة إلى مرشد. ولذلك، كرهها للرجل أو حبّها للانتقام منه ومن المجتمع الذكوري كله، دفعها إلى حبّ بنات جنسها لتستعيض بالعلاقة معهن عن علاقتها بالرجل. لذلك احتالت على المرأة الأميّة، الأرملة التي لم يمسسها رجل بعد وفاة زوجها، ولا وقفت أمام المرأة، ولم تكن تتذمّر، بل وجدت لها نمط حياتها الذي ترتاح إليه. احتالت عليها بما يقوله الكتاب (الثقافة الغربية): “ملامستنا لأجسادِ بعضنا البعض تبعث فينا المحبّة، والتّحليق إِلى أَماكنَ أُخرى … لا بُدَّ أَنْ تلامس كلَّ أعضاء جسدكَ، وتُحسّهُ، وتشعرُ بهِ، وعليك أَنْ تنظرَ إليه كاملاً، كأنَّهُ هالة آتية من البعيد، تحمل إلينا السَّعادةَ والشُّعور بالنَّشوة!” (ص 146-147). يحدث هذا، فقط لأنّها تفقد الرجل الذي يحترمها ويحترم جسدها وأنوثتها. واحتالت على “أم فراس” أيضا، بكلامها المنمّق الذي يقطر شهوة، وأغرتها برغبتها برسمها في لوحة: “أُفكّرُ أن أرسمكِ في لوحة، هل توافقين؟! … اُنظري إِلى نفسكِ وأنتِ تستلقين على الكنبة … لماذا الرّسّامون يرسمون المرأة، ومحظورٌ عليَّ كامرأة أن أرسُمَكِ بهذه الحالة؟” … (هل سترسمينني بقميص النّوم؟ تسأل أم فراس) … نعم أَراكِ الآن أَجمل، فأنتِ لا ترَيْن نفسكِ، والرّسّامون القدماء أَحبّوا المرأة السّمينة كي يُظهروا مفاتنها” (ص 147-148). والحقيقة أنّ “هزار” هي التي افتتنت بجسد “أمّ فراس”، وفعلت كل ما فعلت لتبلغه. لكنّ تحفّظ الكاتبة منع البطلة من الوصف المباشر لما فعلت، وحمّلت الإثم للراوي العليم، يقول: “لم تخطّط هزار طريق الوصول إلى عنق أُمّ فراس … أخذتْ تُلامسهُ، وتنزلقُ بأصابعها إِلى الصَّدر وإلى الخصر … إِلى أخمص القدميْنِ، وتعيد ملامسة الجسد الممدَّد أمامها دون حراك، مرّةً تلو المرّة، وأمّ فراس مغمضة عينيْها، كأنَّها في حلم جميل!” (ص 148). من الواضح أنّ إصرارها على الفعل، لم يكن بحاجة لتخطيط. لقد خدّرت “أمّ فراس” بكلامها وشلّت تفكيرها فأخضعتها لإرادتها ورغباتها. من المشهد، تُشتمّ أيضا رائحة الفكر النسوي (فامينيزيم) الذي نشأ أيضا في الغرب ثم انتقل إلينا.
من حقّ المرأة في مجتمعنا أن تأخذ دورها فيه، وأن تأخذ حقّها من الرجل، ومن المجتمع الذكوري. من حقّها أيضا أن تتمرّد وتنتزع حريّتها وحقوقها كاملة وتقرّر مصيرها بنفسها، كما فعلت المرأة الغربية، ولذلك أتمنّى أن يكون طرح الكاتبة للثقافة الغربية، أو توظيفها للمثلية الجنسية، ينحصر في إطار التعبير عن الحرية والتمرّد، وليس طرحا لحلّ المشكلة التي تعاني منها المرأة في مجتمعنا. نحن مجتمع بلاه الغرب بما هو فيه من مآسي. لذلك، رغم ما في الثقافة الغربية من إيجابيات، فقد آنَ الأوان أن نتحرّر من الغرب ونظرياته التي لم تجد حلّا جذريا للكثير من مشكلاته هو. كما أنّه ليس واضحا: هل حلّت “هزار” مشكلة “أمّ فراس” أم وضعتها في مشكلة؟ ماذا يعني طلب “أم فراس” وموافقتها، ثم أن تنهار وتجهش بالبكاء، حين تقول: “هزار، أطلب منكِ أن يبقى هذا الأمر سرًّا بيننا، أرجوكِ أن تذهبي، فلا أُريدُ التورٌّطَ أكثر … سترسمين جسدي، لكن بثوبي الفضفاض. وأجهشت بالبكاء، هذه المرأة الشّجاعة تبكي! مَن مِنّا لا يبكي؟ (ص 148). “مَن مِنّا لا يبكي؟”، هذا سؤال إنكاري تبريري فقط، تُبرّر به البطلة فعلتها. بماذا يُمكن أن تُورّطها أكثر وقد وافقت أن ترسمها وسمحت لها بمداعبة كل عضو في جسدها، فخرجت “هزار” من عندها خروج المنتصر النشوان بنصره؟ “غادرت هزار، وهي تُحسُّ أَنَّها بعثتْ في جسدِها نشوة وإحساسًا فقدتهما من سنين، وما العيب في ذلك؟ لم تتوقّف عند أيّ عضو لم تعبث بهِ! لامَستْ جسدها واحتوتهُ كلّهُ، كما احتوت “كاترين” جَسَد ابنتها وهي في السّابعة من عمرها، وسوف تنظر “أمّ فراس” إِلى جَسَدِها من الآن فصاعدًا بشكل آخر، وستتعامل معهُ بكلّ حُبّ وشوق، وستصغي إليه وتلاعبُهُ كطفلها المدلّل! إِنّهُ لها وليسَ لأيّ رجلٍ في القرية!! (ص 148-149). هل كان هذا إحساس “أم فراس” أم إحساس البطلة نفسها؟ وهل يعني ذلك أنّها حلّت مشكلتها؟ هل ترى الكاتبة حقّا أنّ حلّ مشاكلنا يكمن في تقمّصنا للثقافة الغربية، أم أنّه مجرّد تعبير عن الحرية وعن حقّ المرأة بتقرير مصيرها بنفسها؟ أتمنّى أن يكون ذلك هو الدافع، كما أرجو أن يكون توظّيف الكاتبة للمثلية الجنسية، جاء ليحمل رسالة إلى النساء عامة، مفادها أنّ حلّ قضية المرأة في مجتمعنا مرهون بتحرّك المرأة نفسها، وبتحريكها لغيرها من بنات جنسها، بذلك تتضافر جهودهن ويصبح الهدف سهل المنال.
في رسمها أو بنائها لشخصية “أمّ فراس”، ارتكبت الكاتبة خطأً لم ترتكبه في غيرها، إذ حمّلتها أكثر من قدرتها، خاصة في اللغة والخطاب. ذكرت سابقا نموذجا بين قوسين، وسأبيّن ذلك بشكل أوسع في حديثي عن اللغة.
المرأة والنضال السياسي، من فضح المجتمع إلى فضح السلطة وعملائها
في الرواية السياسية العربية، القضية السياسية فيها هي الطرح الأول والأساس، وفيها تُقدّم مصلحة الوطن على مصلحة الفرد، ويتراجع حبّ المرأة أمام حبّ الوطن، أو يُضحّي البطل بحبّه وعلاقته بالمرأة من أجل الوطن. رواية هيام قبلان هي ليست رواية سياسية بالمفهوم السياسي للرواية، وإنّما هي ثورة على واقع اجتماعي تعاظم فيه الفساد وتراكم بحيث طال الحياة السياسية للمجتمع. يظهر ذلك من خلال تمرّد بطلة الرواية على المجتمع المتمثّل بأبيها وأخيها وعيرهما ممن ظلموها أولا، ثم تاجروا بالوطن كسماسرة للأرض وعملاء للسلطة. لذلك فهي تفضح نهجهم الفاسد في مجتمعها، بكونه ليس فضحا لنهج سياسي بقدر ما هو فضح لنهج وسلوك اجتماعي فرضته ظروف سياسية معيّنة، خاصة وأنّ السماسرة والعملاء، هم أنفسهم من يُسيطر على المجتمع ويلعب بمقدّراته. وهم الذين تاجروا بأرض الوطن وشرفه بعد متاجرتهم بكرامة المرأة وشرفها. وقد أسقط الواقع السياسي الجديد عن عورتهم، آخر ورقة توت علقت بها.
ما تقدّم، يؤكّده أنّ المواجهة الحقيقية في الرواية، ليست مباشرة مع السلطة السياسية في إسرائيل وإنما مع عملائها، وإن كنّا نستطيع أن نرى بهم رمزا لها. نشهد ذلك أيضا المواجهة، هنا وهناك، في مظاهرة الناصرة والصدام فيها بين المتظاهرين والعسكر الإسرائيلي، وكذلك في الدور المخابراتي الذي يُحاول إسقاط الطلاب العرب كرمز للمثقّف الذي يسعى إلى تقدّم مجتمعه وتحرّره. كون “نزار” هو الذي يقوم بذلك الدور، في الجامعة أو في المظاهرة، ذلك يعني أنّ المواجهة الحقيقية في الرواية هي مواجهة مع المجتمع ورموزه، الذين أسقطهم فسادهم الاجتماعي في فكّ الفساد السياسي. ولذلك، النضال السياسي والوطني الذي تقوم به المرأة في الرواية، البطلة وغيرها من الشخصيات، هو نضال خلقه القهر والألم الذي تعاني منه في المجتمع، لذلك فهو شكل من أشكال التمرّد عليه، تدعم به الكاتبة قضيّتها الأساسية، تحرّر المرأة كخطوة أساسية لتحرّر المجتمع نفسه، أي أنّ حلّ القضية الاجتماعية سيُؤدّي إلى حلّ القضايا السياسية والوطنية على اختلافها. وفي رأيي، كان هذا هو الدافع الحقيقي للمرأة العربية في إسرائيل، للمشاركة في الحياة السياسية، المشاركة في المظاهرات مثلا. وهذا التصرّف كان مرفوضا من المجتمع، على الأقلّ في المراحل الأولى لتطوّر النضال السياسي للأقلية العربية. ولذلك، أولئك النسوة اللاتي شاركن في المناسبات الوطنية وفي المظاهرات ضدّ السياسة الإسرائيلية، هنّ النساء المتمرّدات على المجتمع أولا، وتمرّدهن على السياسة الإسرائيلية هو نتاج تمرّدهنّ على المجتمع ومكمّل له، لأنّ السلطة السياسية تسعى لدوام تخلّف المجتمع العربي وجموده، الأمر الذي يضمن لها سهولة اختراقه واستمرار ولائه. وفي كل الأحوال، للمرأة العربية نصيب الأسد في دفع الثمن.
ذلك ما قامت به هيام قبلان في روايتها. فقد وظّفت النضال الوطني والسياسي من أجل مواجهة المجتمع الأبوي الذكوري الذي ينزع عنها الشرعية، كإنسانة وكامرأة، لأنها امرأة. حاولت الكاتبة أن تُوازي بين نضال المرأة الاجتماعي والسياسي / الوطني، وأصابت بذلك الكثير من النجاح، ولكنّ نجاحها لا يعني تقديم السياسي على الاجتماعي، لأنّ الكاتبة فكّكت بالدرجة الأولى البنى الاجتماعية وفضحت فسادها الذي قادها إلى فضح الفساد السياسي. كذلك لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار، أنّ السمسرة والعمالة، هما فساد اجتماعي قبل كونهما فسادا سياسيا.
الكاتبة لم تتهادن في قضيتها الاجتماعية مع أحد. وكذلك فعلت في قضيتها السياسية / الوطنية. ربطت هيام قبلان بين القضيتيْن ربطا محكما يتجلّى في الرواية في مواضع مختلفة. يظهر ذلك في مناجاتها لأختها “دلال” التي انتحرت قسرا. تقول: “لم تَرحمْكِ ألسِنةُ اللهب في القرية … فهل استشهادك في سبيل إنسانِكِ وكيانِكِ كان شهادة؟ لو أنّ موتَكِ كان في سبيل الوطن، لنثروا على قبركِ الورود، وكلّلوكِ بأوراق الغار، وتوَّجوكِ أوسمةَ البطولة مثل أيّ “شهيدة”! وهل بقيَ خيتاهُ وطن؟!” (ص 30). في هذه الفقرة تساوي بين فقدها المجاني لأختها، وكذلك فقدها المجاني للوطن. والمسبّب واحد في الحالين. كما يظهر ذلك أيضا، في لحاقها بـ “نبيل” إلى المظاهرة في الناصرة رغم قرارها السابق، الابتعاد عنه. ذلك يُؤكّد أنّ هيام قبلان تُؤمن أنّ عدم الانسجام بين المرأة والرجل لسبب ما، وفراقهما مهما كان سببه، لا يُلغي حبّ الوطن الذي يظل قاسما مشتركا بينهما، وكذلك بين جميع أبنائه، لأنّ الوطن هو الحاضن للجميع. وذلك يُحتّم على الجميع اللقاء في الوطن كغاية شخصية وجمعية في آن معا. وعلى الجميع واجب الدفاع عن الوطن وتحريره من مغتصبيه. وهي تُؤمن أيضا أنّ أبناء الوطن المغتصب، لن يستطيعوا تحريره إلّا بتحرير أنفسهم وتخليص مجتمعهم من أدرانه ورواسبه التي تقمع حريتهم وتهدم حياتهم الشخصية والجمعية. يظهر ربط الكاتبة بين القضيتيْن أيضا، في جعل أعداء الوطن الداخليين، هم أنفسهم أعداء المجتمع، وهم أنفسهم عملاء السلطة الذين ساعدوها على اغتصابه. وهنا يتجلّى عدم التهادن مع أحد، مهما كان قريبا، حين رسمت الكاتبة شخصيتي الأب والأخ كأداة لقمع المرأة وخراب المجتمع، وكأداة في يد السلطة تغتصب الأرض وتُذلّ الإنسان.
الأب الذي تفضحه الكاتبة لأنّه غصب ابنته، “هزار” على الزواج ممن لا تقبل به زوجا وشريكا، هو نفسه الذي لم تتورّع من فضحه كعميل للسلطة. فهو الذي كان يدعو إلى “مضافته، الوفود من أبناء عُمومتهِ “اليهود”، الذين أخلص لهم ولدولتهم! لم يكن هؤلاء سوى أصحاب مصالح ومطامع، اشترَوْا أراضي القرية، واستولَوْا على قسمٍ كبيرٍ منها! هُم المنتفعون من الأرض، ومن ملْءِ بطونهم بالطّعام اللذيذ” (ص 27).
و”نزار”، أخو “هزار”، الذي فضحته لأنّه نصّب نفسه رقيبا عليها بعد موت أبيها وزوجها، ليحدّ من حركتها وحريّتها خوفا على سمعته، لم تتورّع أيضا من فضحه كعميل للسلطة وعيْنٍ لها على أبناء قريته وشعبه، المتمثّلين في الرواية، بالطلاب الجامعيين، زملاء ابنتها “سمر”، وبأبناء قريتها الشرفاء، رافضي الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال. يراقبهم ليوقع بهم في أيدي السلطة التي تزجّ بهم في سجونها، لتمنعهم من ممارسة دورهم في الكفاح من أجل الوطن ومن أجل انتزاع حقوقهم وحقوقه. يتجلّى فضح “نزار” على لسان “سمر” حين قالت: “خالي يعملُ مع الشّرطة يا أمّي! … أنا متأكّدة من ذلك! … الآن أنا متأكّدة أنَّ خالي وراءَ القبضِ على عَدَدٍ من الطّلاّب يوم المظاهرة”. (ص 56). ويتجلّى كذلك في قول “هزار”: “يا إلهي … أأنتَ أيضا يا نزار تُعيدُ حماقة أبيكَ؟ أيُمْكن أن تَكونَ عميلاً ضدّ أبناء جِلْدتك ووَطَنكَ؟” (ص 56). وحماقة الأب هي هنا إشارة للاجتماعي وليس للسياسي فقط. فالأب قبل حماقته السياسية، العمالة، ارتكب الحماقة نفسها بمعاملته لزوجته وبناته. و”نزار”، هو الامتداد، فهو من وشى بجاره رافض الخدمة في الجيش، فطوّقت الشرطة بيته، “وعندما لم يجدوهُ في المنزل، كانتْ تتطايرُ مِنْ النّوَافِذ مَلابِسُهُ … أوانيه … شراشِفه … كُتُبُهُ وأوراقهُ” (ص 56). تفضحه “هزار” أيضا من خلال موقفه الهازئ بجاره وأمثاله من الشرفاء، فهو الوحيد الذي تكلّم تلك الليلة قائلا عنهم: “يعيشونَ بِفَضلِ دَولَتِهم، ويَبْصُقونَ في صَحنِها؟ لا يَعرِفون أينَ سَيَهْرُبونَ من وجهِ الحَقيقة … مَصيرُهُم السَّجن والضَّياع!” (ص 57). الخيانة والعمالة والنفعية أعمت بصره وبصيرته، وجعلته يتحدّث عن أبناء جلدته، أبناء بلدته، أهله وجيرانه، كأعداء غرباء.
وتفضح كذلك زوجها “كريم”، شريك أبيها في مؤامرة اغتيالها، زواجه منها قسرا. تسخر منه سخرية مبطّنة تنزف ألما، وتعبّر عن مدى احتقارها له حين تصفه بـ “فارسُ الوطنِ، حاملُ البندقيّة ورجلُ الرّصاصِ، بدلتُهُ كاكيَّة ونجوم لامعة على كتفيه! إنّه حارسُ ليلِ الوطن … يا للسخرية!” (ص 17-18). واضح أنّ بدلة “كريم” تمثّل السلطة وانضوائه تحت عباءتها بعمالته لها. يفضح ذلك تصرّفه أيضا، فهو “لم يُدْهش بموقفِ “نزار”، وضحكَ ضحكةَ استِهْزاء من كلِّ رافضي الخدمة الإجباريّة، ومَن جعلوا يُهَروِلونَ وراءَ أبواقٍ لسياسةٍ عمياء!” (ص 57).
وتفضحهم جميعا، اجتماعيا وسياسيا، كرموز للمجتمع الذكوري، وكعائلة من السماسرة والعملاء للسلطة. تقول: “كريم … نزار … والدي … خالي … كما صادرَ الوَقت أرضي صادَرْتُم الكَرامَة، وتَعاونْتُم في بيعِ الأراضي، يا سَماسِرة الزّمن في تهجير شباب المستقبل!” (ص 57). عبارة “صادر الوقت أرضي” فيها إشارة إلى القضية الاجتماعية السابقة على القضية السياسية.
يتجلّى اهتمام الكاتبة بالقضية الوطنية، في وقوف “هزار”، بطلة الرواية، موقفا بطوليا ضد السلطة وعملائها، وضدّ التجنيد الإجباري ومن يدعمه من أبناء جلدتها. وهو موقف يتماهى مع موقف الكاتبة في الظروف القاسية التي تجمع بين كلتيهما. ولكن، يبقى الهدف الأساس من تلك الصرخة المدوّية، هو أنّ خلاص المجتمع من السلطة السياسية واستبدادها، رهين خلاص المجتمع من أمراضه الاجتماعية أولا، بعد ذلك فقط يأتي خلاصه من أمراضه السياسية. ولا يشفى المجتمع من أمراضه الاجتماعية إذا لم يتخلّص من تخلّفه وسلطته الأبوية الذكورية. وهنا تكمن إشارة الكاتبة إلى المرأة ودعوتها لها أن تتمرّد وتبادر إلى خلاصها، فإنّ خلاصها هو خطوة أساسية لخلاص مجتمعها، وتحرّره الاجتماعي سيُؤدّي حتما إلى تحرّره السياسي والوطني. ذلك لأنّ “هزار” التي لحقت بحبيبها، “نبيل”، إلى المظاهرة، هي “هزار” التي قرّرت أن تُغرّد خارج السرب. فقد حرّرت نفسها من سلطة المجتمع، سلطة أبيها وزوجها وأخيها، ثم اندفعت إلى المظاهرة، إلى نضالها السياسي دفاعا عن الأرض والوطن.
ثقافة الكاتبة ودورها في الرواية
بمجرّد معرفتنا أن الكاتبة شاعرة أصدرت عددا من المجموعات الشعرية، ذلك يوحي لنا بأنّها إنسانة مثقّفة. ولكنّي لا أقصد هنا ثقافتها العامة بقدر ما أقصد ثقافتها الخاصة، أي تلك التي انعكست في الرواية من خلال مؤشّرين. الأول، ثقافة “هزار”، بطلة الرواية، والثاني قصة “الجَنّان”. المؤشّر الأول يترك أثرا سلبيا إلى حدّ ما في نفس القارئ، حيث تبدو ثقافتها متأثرة ببعض جوانب الثقافة الغربية التي نقلتها، بسطحيّة ما، إلى الرواية. فهي لا تحمل حلولا، لا لمشاكلها الشخصية، ولا لمشاكل المرأة عامة في مجتمعنا. وأكثر من ذلك، فإنّ ما اقتبسته منها، لم يحمل حلولا لمشكلة المرأة الغربية، بل عبّر عن نقدها للمجتمع الذكوري الغربي وتمرّدها عليه وبحثها عن حلّ مشاكلها بواسطة جهودها الذاتية، كما برز ذلك في اقتباسها من الكاتبة أو الباحثة الغربية. ودليل تأثّرها بها كممثّل للثقافة الغربية هو تقمّص “هزار”، بطلة رواية قبلان، لشخصية “كاترين”، بطلة رواية الكاتبة الغربية. تحدثت سابقا عن تأثّر الكاتبة، هيام قبلان، بالكاتبة، “تسيبي جون غروس”، وروايتها “أعشق جسدي”، اللتيْن لم أعثر لهما على أثر في الشبكة، لا باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية، رغم أن الكاتبة تذكر أنّ الرواية مترجمة للعربية. وقد بيّنت أيضا، الأثر السلبي لتلك الثقافة على شخصية البطلة ومن خلالها على شخصية “أم فراس”، في توظيفها للعلاقة المثلية بينهما. ولكيلا أتجنّى على الكاتبة، يظلّ ما طرحته مجرّد وجهة نظر قابلة للنقاش.
المؤشّر الثاني، قصة “الجَنّان”، يحمل أثرا سلبيا واحدا، وهو ذلك الملمح البرجوازي الغربي الغريب على واقع المجتمع العربي القروي الذي عاشت فيه الكاتبة أو بطلة روايتها، وفيما عدا ذلك، فالمؤشّر يعكس قدرة الكاتبة على توظيف ثقافتها في الرواية توظيفا فنّيا خدم جمالية الرواية وما تطرحه الكاتبة فيها من أفكار. فما دامت الكاتبة اعترفت بانّها تقرأ الأدب الغربي، المترجم منه على الأقلّ، ليس غريبا أنّ تكون قد استوحت قصة اغتصاب “الجَنّان” لبطلة روايتها، “هزار”، من قراءتها لرواية “عشيق الليدي تشاترلي” للكاتب الإنجليزي، د. هـ. لورانس، فهي مترجمة للعربية. إذا قرأت الكاتبة الرواية فقد واستوحت منها قصة “الجَنّان”، ولكن فاتها أنّها تنقل مع بعض ما استوحته منها، بعض ملامحها البرجوازية الغربية. وإذا لم تقرأها، ذلك لا يمنع أنّ الصدفة لعبت دورها في أنّ هناك الكثير من ملامح الشبه بين بعض شخصيات الروايتين وأحداثهما.
“الجَنّان” في رواية “رائحة الزمن العاري”، فيه ملامح من الحارس، “حارس الطرائد” في رواية “عشيق الليدي تشاترلي”، لكونه قويّ البنية، كما وصفته “هزار”، التي حاول اغتصابها، فقد جاء في الرواية أنّ “جسده شبابيّ مفتول” (ص 36). وقد استوحت الكاتبة بداية عمل “الجَنّان” في حديقة بيت “هزار” من فترة تواجد “كوني” أو “الليدي تشاترلي”، بطلة الرواية، في منطقة “راغبي” التي تدور فيها أحداث الرواية الإنجليزية. تقول الرواية: “مضى على “كوني” الآن في راغبي مدّة سنتين” (ليدي، ص 43)، و”الجَنّان” في “رائحة الزمن العاري”، كما تقول البطلة إنّها “لا زالت تذكر أنّها استدعته للاعتناء بالحديقة منذ عامين” (ص 35). وأكثر من ذلك، “كوني” ذهبت إلى عشيقها برجليها، عندما وافقت زوجها أن تحمل رسالته إلى الحارس (ليدي، ص 108)، بينما الكاتبة حوّرت هذا المشهد ليخدم أفكارها، فجعلت “هزار” تُحضر مغتصبها إلى بيتها بنفسها عندما ذكرت “أنّها استدعته للاعتناء بالحديقة” (ص 35). في كوخ “الحارس” الذي تردّدت إليه “كوني”، حدث اللقاء الجنسي بينهما (ليدي، ص 178 وما بعدها)، وفي بيت “هزار”، الذي أحضرت إليه “الجَنّان” بنفسها، حدثت محاولة الاغتصاب. تلك الأحداث تُؤكّد الشبه في بعض الملامح بين “الجَنّان” و”الحارس”، وبين “هزار” و”كوني”. كما أنّ هناك شبها لا يقلّ أهميّة، هو الشبه بين ملامح “أم فراس” وملامح “الليدي بينرلي”. فهذه الأخيرة شجّعت “كوني” حيث ألقت “يدها النحيلة على ذراع كوني (قائلة لها): على المرأة أن تعيش حياتها، وإلّا ندمت لماذا لم تعش حياتها. صدّقيني” (ليدي، ص 119)، و”أم فراس” شجّعت “هزار” على أن تعيش حياتها، عندما قالت لها: “يجب أن تلبسي ما يناسبُ قوامكِ، فجسمكِ جميل، وما زلتِ فتيّة وفاتنة، لِمَ لا تفكّرين بالزّواج؟” (ص 121). وقالت لها أيضا: “هل تهدرين عمركِ وأنت بانتظار، الجسد بحاجة لرجل” (ص 122).
بما أنّي قرأت الروايتين، وأعدت قراءة “عشيق الليدي تشاترلي” للتأكّد من تلك الملامح، صار من الصعب عليّ أن أتعامى عن ذلك التشابه بينهما ولا أشير إليه، رغم معرفتي أنّ الصدفة قد تكون لعبت دورها.
أن يتأثّر كاتب بكاتب آخر، ويفعل ما فعلته هيام قبلان، إذا قرأت رواية لورانس، ليس بالأمر الغريب ولا المرفوض. وقد يحدث لدى من هم أطول باعا في مجال الرواية منها. ولكنّ ما استوقفني في ثقافتها، هو ما لمسته من المؤشّر الأول، حيث وظّفت الكاتبة الثقافة الغربية في روايتها بشكل لا يتّفق مع تطلّعات مجتمعنا، قبل تحرّره وبعده، اجتماعيا أو سياسيا، لأنّ تحرّرنا يجب أن ينبع من ذاتنا وليس من الثقافة الغربية التي لم تغيّر شيئا عبر السنين من نظام الغرب الإمبريالي الذي يستعمر الشعوب ويقمعها، يُدمّر حضاراتها الأصيلة وينهب مواردها. وليضمن دوام بطشه وطغيانه، يعمل على دوام تخلّف أنظمتها الاجتماعية واستبداد أنظمتها السياسية. وإذا جانبني الصدق فيما طرحته حول المؤشّر الأول، فإنّ “الجَنّان” وعمله في بيت “هزار”، يظلّ أثرا وملمحا برجوازيا غربيا وغريبا على واقع المجتمع العربي القروي الذي عاشت فيه الكاتبة أو بطلة روايتها، سواء قرأت الكاتبة رواية “الليدي تشاترلي” أم لم تقرأها.
الشكل الفنّي واللغة
هناك ثلاث عتبات بارزة للنص. الأولى في الغلاف الأول (غلاف الطبعة الثانية)، حيث العنوان، “رائحة الزمن العاري”، على خلفية أرض عطشى وشجرة عارية إلّا من بعض القناديل المعلّقة بها، وجذورها يد مغروسة في الأرض. والثانية، عبارة مقتبسة من أقوال الكاتب الفرنسي “ميشيل دي مونتين”: “لا شيءَ يُرَسِّخُ الأشياءَ في الذّاكِرَةِ وَيُثَبّتها كالرّغْبَةِ في نِسْيانِها” (ص 5). والثالثة، الإهداء، “إلى طائِر الفينيق، الخارج من الرّمادِ، “نَمْلِكُ أن نَحْيا مَرَتَيْنِ” (ص 7). في العتبات الثلاث إشارة إلى ما تعرضه الرواية من جفاف الماضي ورماده وتثبيت الحاضر له في الذاكرة رغم الرغبة بنسيانه. وفيها استشراف للمستقبل، يتمثّل بالقناديل المعلّقة على الشجرة العارية، وباليد المغروسة في الأرض والتي تمثّل التمسّك بها، وبالعنقاء، أو طائر الفينيق، الذي ينطلق من الرماد كرمز للأمل بحياة ثانية ومختلفة، ما يُشير إلى المستقبل الذي تحلم به الكاتبة وبطلة روايتها.
قدّمت لنا الكاتبة رواية فنيّة، يلعب التجريب في بنائها ولغتها دورا واعيا يقوم على التداعي حيث البوح، من خلال التنقل في الزمن والمتح من الذاكرة، وعبر المونولوج المباشر وغير مباشر. نجحت الكاتبة بتوظّف تقنيّات تيار الوعي، بشكل يبيّن تمكّنها ويُثري جمالية روايتها التي قسّمتها إلى ستة عشر فصلا. من الأول، وبعد بيان حاضر السرد، تقوم الفصول التسعة الأولى على الاسترجاع، حيث تمتح البطلة تفاصيل معاناتها من الماضي القريب، لقائها مع “نبيل” بعد عودته من الغربة وما تلا ذلك من أحداث، ومن الماضي البعيد، قصة حبّها لـ “نبيل” وتاريخ أسرتها وضلوع الرجل بقمع المرأة وقهرها في المجتمع الذكوري المتخلّف. في بداية الفصل العاشر، تعود الكاتبة إلى الحاضر، حاضر السرد، لتسرد الأحداث حتى نهاية الرواية في الفصل السادس عشر، أي من لحظة ابتعادها عن “نبيل” إلى لحظة موته على صدرها آخر الرواية. تتداعى الأحداث في ذهن الراوي العليم الذي يمثّل صوت الكاتبة، نتيجة قرار “هزار”، البطلة، الابتعاد عن حبيبها، “نبيل”. هذا القرار والبدء بتنفيذه يُشكّلان إرهاصا للتداعي، ولذا اتخذت منه الكاتبة حاملا للسرد.
تقنيّات السرد والشكل السيري
كما ذكرت، تتخذ الكاتبة من قرار البطلة بالابتعاد عن حبيبها، “نبيل”، والبدء بتنفيذه، حاملا للسرد. وهو الأمر الذي يفرض التداعي ويُمكّنها، أثناء ابتعادها عن “نبيل”، من استعادة أحداث الماضي القريب، ثم من جوب الأزمنة على أشكالها من الحاضر إلى الماضي القريب والبعيد وإلى المستقبل، كما سأبين ذلك في حديثي عن الزمن.
لأول وهلة يعتقد القارئ، وحتى القارئ الناقد، أنّ جرأة الكاتبة أوقعتها في فخ الشكل السيري. ولكنّ التوغّل في قراءة الرواية يكشف لنا أنّ لديها من المعرفة بأسرار الرواية، ما يجعلها تُدرك جيدا أبعاد المغامرة التي هي مقبلة عليها، وتدرك أيضا كيف تدرأ عنها، فنّيّا، تبعات تلك الشبهة، السيرة الذاتية، رغم ما يظهر من عدم اهتمامها، لأنّ كل ذلك لا يعفيها من تلك الشبهة، خاصة بين أولئك الذين يعرفونها شخصيا، والذين سيربطون بين حياتها وحياة البطلة، “هزار”، التي تتماهى معها في الموقع الجغرافي والاجتماعي والنفسي. فالكاتبة ابنة قرية “عسفيا”، القرية الكرملية القريبة من حيفا. والبطلة، “هزار”، تعترف بأنّها “ابنة القرية الأقرب إلى حيفا” (ص 77). هذه القرية، سواء كان ذلك في الواقع أو في الرواية، هي الموقع الجغرافي والاجتماعي والنفسي، الذي تنطلق منه الكاتبة وأحداث روايتها. والكاتبة تنتمي للطائفة العربية الدرزية، والبطلة كذلك، وإن لم تقل ذلك صراحة. ولكنه يبدو واضحا تماما في التحاق شباب قريتها بالجيش الإسرائيلي وتجنيدهم الإجباري. وكذلك في امتناع بعضهم عن الخدمة الإجبارية لأسباب ضميرية ووطنية.
يتولّى السرد في الرواية راوٍ عليم (كلي المعرفة)، مطّلع على كل خبايا شخصياته. وهو يمنح ثقته بشكل خاص لشخصية البطلة، بحيث يتداخل صوته بصوتها، صوت “الأنا” الراوي والمروي عنه. يظهر ذلك في إتاحة منصّة السرد للبطلة وبضمير المتكلم، في كل لحظة تحتاج فيها للبوح، عبر المتح من الذاكرة أو في حوارها الداخلي مع نفسها عبر المونولوج المباشر وغير المباشر. تعدّد الأصوات، وبشكل خاص صوت الراوي العليم رغم ما فيه من تداخل مع صوت الكاتبة وصوت البطلة، ينفي شبهة السيرة الذاتية عن الكاتبة. ولكن جرأة اعترافات البطلة تُؤكّد التماهي بينها وبين الكاتبة. ذلك الأمر، يشير إلى جرأة الكاتبة نفسها، وعدم اهتمامها، أو خوفها مما قد يقرّره القراء كممثل للمجتمع، أي سواء عندها إذا قرّر القراء أنّ “هزار” هي هيام قبلان أو لم يفعلوا.
يظهر تعدّد الأصوات أيضا، في الحوار المباشر بين الشخصيات، حيث شخصية البطلة طرف دائم فيه. والحوار المباشر بين الشخصيات، وإن كان يعيق حركة السرد، إلّا أنّه يكشف عن أمور وأحاسيس لدى الشخصيات، يشهدها القارئ بشكل مباشر، الأمر الذي يزيد من تفاعله مع الرواية، ويستفزّه بين القبول والرفض لما يحدث فيها. كما أنّ الحوار المباشر يُهيّأ الشخصية والقارئ لأحداث ستأتي. وهذا يعكس قدرة الكاتبة على ربط أحداث الرواية بأزمنتها وعناصرها الأخرى. ما يعني أنّ الكاتبة قدّمت لنا حبكة متماسكة قلّما نصطدم فيها بعناصر ضعف لن أتوقّف عندها، لأنّها لا تفقد الحبكة تماسكها.
الزمان والمكان
الزمن الموضوعي للرواية، هو فترة قصيرة نسبيا، لا تحدّدها الرواية تماما، ولكنها لا تتعدّى الأسابيع أو الأشهر على أبعد تقدير. إنّه الفترة الممتدّة بين بداية تنفيذ البطلة لقرارها، الابتعاد عن حبيبها، “نبيل”، وبين نهاية الرواية بموته. على المستوى الاجتماعي تشهد تلك الفترة تمرّد “هزار” ومواجهتها الحقيقية للمجتمع الذكوري الظالم المتمثّل بشخصية أخيها، “نزار”. وتشكّل على المستوى السياسي أو الوطني، إرهاصا لمظاهرة الناصرة، أو هبة أكتوبر 2000، التي تنتهي الرواية بها وباستشهاد “نبيل”.
تبدأ الرواية في لحظةٍ تُشكّل مفصلا بين الماضي والحاضر. من الماضي القريب، استرجعت البطلة، لقاءها المفاجئ في مكتبة القرية، مع “نبيل”، ابن بلدها، الشاب الوطني الذي أحبّته، إلّا أنّ والدها أرغمها على الزواج بغيره. القهر والحصار ودسائس عملاء السلطة، أرغمت “نبيل” على الهجرة القسرية والغياب عن القرية لمدة عشرين عاما، انتهت بذلك اللقاء المسترجع.
خلال استرجاع البطلة للقاء وما تلاه من أحداث، تداخلت الأزمنة بين الماضي القريب والبعيد، حيث استرجعت البطلة المعاناة التي عاشتها وما مرّت به من أحداث خلال العشرين عاما، وكذلك المعاناة التي عاشتها المرأة / البطلة في أسرتها، منذ بداية وعيها. في هذا الشطر من الرواية، عرضت الكاتبة القضية الأولى، قضية المرأة، حيث واجهت البطلة، وغيرها من نساء أسرتها، ظلم المجتمع الذكوري بأشكاله المختلفة، وقمعه للمرأة وقهره لها. وفيه أيضا، بدأت تنمو لدى البطلة بذور التمرّد، ثم اكتشاف حاجتها له كشرط لخلاصها. يستمرّ الاسترجاع إلى حاضر السرد، حيث البداية الحقيقية لأحداث الرواية، إذ تقول: “كانَ لا بدَّ لزهرةِ اللَّيلَك أَن تَنْحني، فَيَسْقُط ظلُّها ويستريح!” (ص 9)، ما يعني أنّ البطلة، المشار لها بـ “زهرة الليلك”، بحاجة إلى فترة من الراحة من معاناة هموم الماضي واستمرارها في الحاضر، لذلك تتخذ قرارها الشخصي بالابتعاد عن “نبيل”، لتخرج من حياته وتبتعد عن “ذلّ رجل لم تتّسع ذاكرته لعطر امرأة” (ص 9). وهي إشارة إلى أنّ ظروف “نبيل”، الشخصية والاجتماعية، وظروف القلّة التي يُمثّلها من رجال المجتمع، وكذلك ظروف البطلة ومن تُمثّلهنّ من نساء، لم تكن مهيّأة لاستمرار تلك العلاقة، بسبب ظروف المجتمع المغرقة في التخلّف والقمع، وضلوعه في قتل الحلم الذي كان “نبيل” يُمثله في نفس “هزار” والكاتبة معا. ذلك المجتمع تصفه الرواية بأنّه “لا يُؤمنُ بصدقِ العواطف، ولا بعشقٍ منَ الممكنِ أن يدومَ” (ص 10). عن تلك الظروف تكشف البطلة تدريجيا من خلال تداعي الأحداث ولجوئها إلى الاسترجاع والمتح من الذاكرة والبوح عبر المونولوج بأشكاله. وبسببها، تقوم البطلة وترحل بلا اعتذار، مؤكّدة أنّ “نبيل” سيصبح بالنسبة لها ماضيا “لَنْ تعودَ (أليه) … سَوْفَ تُصرُّ على قرارها، وتعلن للشَّجر والشَّمس والهَواء أن لا تراهُ بعدَ اليوم … سوف تستأصله من شرايينها وتنفث الماضي، ذلك الماضي الذي عاش في أطراف أصابعها، وفي قعر مساماتها” (ص 9-10).
يبدو القرار اختيارا قسريّا في آن معا، فرضته عقلانية البطلة، لأنّ البداية الحقيقية لحاضر السرد، تعني أنّ البطلة بدأت مرحلة جديدة في حياتها، هي مرحلة انطلاقها لتقرير مصيرها بنفسها، وبحثها عن ظروف جديدة تستحقّ أن تعيش فيها مثل تلك العلاقة النبيلة، التي قطعتها في الواقع، ولكنّها شخصيا، ظلّت راسخة في أعماق نفسها. يؤكّد ذلك استدراكها وتساؤلها: “لكن … أيُّ ماضٍ سَوف تَسْتَأصل، وما زال يتسلَّلُ ليلاً من نافذتها، وَيدسُّ جَسَدهُ تحتَ غطائها، فيسامرُها ويداعبُ أفكارَها، ويتحسَّسُ مشاعرها دون أن يُسدِلَ سَتائرَ الغربَةِ عليهما؟” (ص 10). ويُؤكّد ذلك أيضا، شعورُها بعد أن خرجت من بيت “نبيل”، إذ تقول الرواية: “قذِرٌ هذا اليوم … يُدخلُ في نفسها الشّؤم!” (ص 10). وأكثر من ذلك، فإنّ “نسمات الهواء المنبعثة من البحر أعادتها إلى لقاء أيقظ فيها أحاسيس المرأة من جديد!” (ص 11).
تمتح البطلة من ذاكرتها، ذلك اللقاء مع “نبيل”، في مكتبة القرية بعد عشرين عاما من الغياب، الأمر الذي يعيدها عشرين عاما إلى الوراء لتغرف من الذاكرة أيضا قصة حبّها لـ “نبيل”، وزواجها قسرا من “كريم”، واضطرار “نبيل” لترك البلاد واللجوء إلى الغربة والمنفى. كما أنّها في مراحل مختلفة من سير الأحداث وتداخل الأزمنة، يستبدّ بها اللاوعي على شكل مونولوج يحفر في لاشعورها، فتبوح بكل ما يعتمل في أعماق نفسها، تنفث غضبها على المجتمع الذي يقمعها، يدمّر حياتها ويسلبها أبسط حقوقها، فتفضحه وتنتقم منه.
تنتهي الرواية، بموت “نبيل”، إذ “على صدر هزاره كانت شهقته الأخيرة … وأسلمها روحه!” (ص 221)، بعد إصابته برصاص العسكر الذي هاجم المتظاهرين في الناصرة. وبيد “نزار” تنتزع جثّته من بين يديها، حيث تقول: “مِن نفس المكان النّازف، امتدّت كماشة عقرب إلى كتفيْها، تلسعها وترفعها بقوّة عنيفة، أتراها “يدُّ الزمن”، أم عقرب “نزار” الّذي سمّمها وتربَّعَ على ناصية العمر؟ ابتلعت ريقها المخضّب بدم “نبيل”، حين امتدّت يد “نزار” تُسْقط جثّة حبيبها من بينَ يديها” (ص 222). وهي نهاية مفجعة ومتشائمة. ولأنّ الكاتبة لا تريدها كذلك، فهي تريدها نهاية مفتوحة على مستقبل يزهو بالتفاؤل والأمل، لذلك جعلت بعيني بطلتها “غصن أنين الجرحى يخضرّ” (ص 223)، وأغلقت روايتها في عبارتها الأخيرة، بصوت ابنتها “سمر”، حيث “من بين الجموع سطع ضوء من هتاف الربّ يتعالى: أماهُ … أمّاه… انتَظريني…!” (ص 223).
زمن الرواية الموضوعي، يتزامن أو يتوازى مع إرهاصات وأحداث هبّة أكتوبر عام 2000، التي قامت بها الجماهير العربية في إسرائيل، بعد دخول شارون، رئيس حكومة إسرائيل آنذاك، محاطا بالجنود ورجال الشرطة والمستوطنين، إلى حرم المسجد الأقصى. هذا التزامن يؤكّده ما ذكرته الرواية، “تفرّقت الجموع … ونُقل الجرحى بسيّارات الإسعاف، ونقلت ثلاث عشرة جثّة شهيد!” (ص 222). هذا العدد، (13)، هو عدد الشهداء الذين سقطوا في هبّة أكتوبر 2000. وذلك يشير بكل وضوح إلى تداخل الهمّ الشخصي بهمّ الوطن، وضرورة فضح العملاء من أبنائه الذين يساهمون مع السلطة في دوامه. ومما يزيد في صدق الكاتبة ومصداقية روايتها، هو أنّها تعالج قضية ما زالت مستمرة حت اليوم. وأحدث القدس وانتهاك المستوطنين لحرمة المسجد الأقصى مؤخرا، شاهد على ذلك.
رغم ما حقّقته الكاتبة وبطلة روايتها، على المستوى الشخصي، من تمرّد وثورة وانتزاع لحريتها، إلّا أنّها لا تنكر أنّ الواقع ما زال معتما، بسبب استمرار ثنائية “الضحية والجلّاد”. الضحية تتمثّل بالبطلة وحبيبها “نبيل”، أي المرأة بشكل خاص، والناس الوطنيين الشرفاء بشكل عام. والجلاد، يمثّله “نزار” وغيره من العملاء والسلطة التي تقف وراءهم. ولكنّ الواقع وزمنه العاري، عاجزان عن قتل الأمل واستشراف مستقبل أفضل، متمثّلا بـ “سمر”، ابنة “هزار”، التي تتعلّم في الجامعة، وتشارك في النضال مع زملائها الطلاب. وعليه، فإنّ الرواية بمجملها، هي زفرة ألمٍ تُعرّي الزمن وسلطاته المستبدّة، وصرخة تفضح رائحته ورائحتهم الفاسدة التي أخذت تملأ المكان، فآن أوان نبذها والتخلّص منها. ولأنّ الرواية كذلك، ولأنّها انتهت بالشكل الذي انتهت فيه، فهي تُجسّد إشراقة تحمل الأمل وتستشرف مستقبلا أفضل لأجيال ستأتي.
ترتبط أزمنة الرواية بمكانها وفضاءاته المختلفة. ثلاثة فضاءات بارزة للمكان. وهي تمثّل الشخصي والجمعي الذي ترتبط به البطلة بأشكال مختلفة. أولها، قرية البطلة التي لم تذكر باسمها، ولكن بوصفها القرية العربية الأقرب إلى مدينة حيفا، فيها تبدأ الأحداث وتنطلق إلى الفضاءات الأخرى. وثانيها، مدينة حيفا التي ترتبط بها البطلة ارتباطا روحيّا وثيقا ومتعدّد الأشكال، بين الجغرافي والاجتماعي والمهني والشخصي، وما فيها من ارتباط نفسي، حيث أنّ بعضا من لقاءات البطلة بحبيبها، تمّت في بيته / غرفته المستأجرة في حيفا. كما أنّ في حيفا تُقام معارض الرسم التي تختلف إليها البطلة كمشاهد أو كرسامة مبدعة تُفكر بإقامة معرض لرسومها. وبها أيضا يرتبط الناس اقتصاديا، ولهذا تختلف “أم فراس” إلى أسواقها، تبتاع منها الألبسة النسائية لتسدّ حاجة بعض نساء القرية. من خلال العلاقة بين قرية البطلة ومدينة حيفا، تظهر أيضا ثنائية القرية والمدينة وما تمثلانه من انغلاق مجتمع الريف على أعرافه وقيمه، وانفتاح مجتمع المدينة رغم ما فيه من تفكّك الحياة الاجتماعية. هذا ما يشير إليه اختيار الكاتبة لمكان اللقاءات الحميمية مع “أدهم” و”نبيل”، لأنّ القرية ومجتمعها المغلق لا يمنحانها الفرصة التي تمنحها لها حيفا / المدينة. وهو تعبير عن دعوة الكاتبة إلى الحرية وانفتاح المجتمع، ونبذها للأعراف والقيم المتخلّفة التي تكرّس عبودية المرأة وحرمانها.
الناصرة هي الفضاء الثالث. ولكنّها كمدينة هنا، تلعب دورا مختلفا عن حيفا. فهي لا تُذكر هنا باعتبارها طرفا في ثنائية القرية والمدينة، وإنّما باعتبارها قلب الجليل النابض وعاصمة الجماهير العربية. فهي تمثل الهمّ الجمعي والقضية الوطنية. الناصرة هي أكثر موقع يحتضن مظاهرات الجماهير العربية واحتجاجاتها على سياسة السلطة المستبدّة ضد الأقلية العربية في إسرائيل أو ضدّ سياسة الاحتلال الذي يجثم على صدر الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلّة.
الفضاءات المختلفة، لا تعبّر عن ارتباط البطلة بها فقط، وإنّما عن القلق الذي ينتابها جرّاء ذلك الارتباط، أي أنّ العلاقة مع المكان هي علاقة موضوعية ونفسية، على المستويين، الشخصي والجمعي. يبرز ذلك على المستوى الشخصي في حيفا، نتيجة لقاءاتها العاطفية السريّة فيها بـ “نبيل” و”أدهم”. ويبرز على المستوى الجمعي في الناصرة نتيجة الأحداث التي ذكرتها سابقا، ومشاركة البطلة فيها. أمّا في القرية فيبرز ذلك القلق على المستويين، لأنّها تجمع بين الضحية وجلّادها فالقرية تحتضن معاناتها الشخصية، ومعاناة الناس الشرفاء من أبناء قريتها الذين تناصبهم العداء سلطة اجتماعية وسياسية، يمثلها بعض من رموز القرية.
ثلاثة فضاءات بارزة في القرية تُعبّر عن الأجواء الحميمية التي تعيش فيها البطلة. ولكنّ ما يُميّز تلك الفضاءات، هو تحوّلها الذي تفرضه الظروف الاجتماعية، إلى إثارة مشاعر الخوف والقلق في نفس البطلة. بيت البطلة يضمّها ويمنحها الأمان، “فغرفةُ هزار المُطلّة على الغابة القريبة، تُشرفُ على حديقةٍ مليئة بألوان الزّهور … إنّه مكانها الآمن، الذي حَمَى سرّ حُبّها لـ “نبيل”، بل أفضل الأمكنة لاستعادةِ الحلم” (ص 23)، إلّا أنّ “الجَنّان” ومحاولة اغتصابه للبطلة، وكذلك أخوها “نزار” ومحاولته السيطرة عليها والتحكّم بتحرّكاتها، زعزعا ذلك الأمان الذي كانت تعيشه في بيتها، فأصبح مصدر خوف وقلق وتوقّع أحداث مجهولة قد تقع. وهناك فضاء آخر كان حميميّا يمدّ البطلة براحة نفسية تحتاجها. تقول الرواية: “نهضتْ بعد ليلٍ استعادتْ فيهِ ماضيًا بأكملهِ، ونظرت من وراءِ السّتائر، لتستقبلَ نهارًا آخر استدعاها للنّزهة في أحضان الطّبيعة، كما كانت تفعل بعدَ رحيل “كريم”! كانت تهرولُ إلى الغابةِ القريبةِ من منزلها، في تلكَ القريةِ الرّابضة على قمّة الجبل، فتُروّح عن نفسها، وتلتقط الهواءَ النَّظيف، وتبني لنفسها بيتًا أرجوانيًّا، يعبقُ برائحةِ الأقحوان والنّرجس البرّيّ!” (ص 20-21). إنّه الغابة القريبة التي كانت تزورها “هزار”، تتمشّى فيها وتروّح عن نفسها، تستنشق فيها الهواء النظيف الذي يشحنها بطاقة جديدة، “ولكنّ القيل والقال وثَرْثَرة نساء القرية اتّهِمَتها بالجحود، ولم ترحمْها عيونُ أهل القرية!” (ص 25). من الواضح أنّ اندفاع البطلة للترويح عن نفسها في الغابة القريبة، كان بعد “ليلٍ استعادت فيهِ ماضيًا بأكملهِ”، ما يشي بأنّ الغابة تمثّل لها حاضرا أهدأ، ومستقبلا أجمل “تبني لنفسها (فيه) بيتًا أرجوانيًّا، يعبقُ برائحةِ الأقحوان والنّرجس البرّيّ”. ولكنّ هذا الحلم أيضا، يكتنفه ما يُعكّر صفوه وإمكانية تحقيقه، الثرثرة والقيل والقال وعيون أهل القرية، أي قيم المجتمع واعرافه المتخلّفة، التي تُمثّل حصاره الذي يفرضه على المرأة.
الفضاء الوحيد الذي انقلبت فيه الصورة، حيث كانت “هزار” تخافه للأسباب السابقة، الثرثرة والقيل والقال، ولكنّها اكتشفت أنّه مصدر راحة يُشعرها بالأمان ويُخفّف عنها هموم الفضاءات الأخرى، هو بيت “أم فراس” وصدرها. لقد تأخّرت البطلة في اكتشاف الحقيقة وبناء علاقة مع صاحبة البيت. فقد كانت ترى فيها مجرد امرأة ثرثارة لا يُؤتمن جانبها. فهي “تدعو النّساء لارتِشاف قهوة الصّباح، بعدما أصبح منزلها مركزا للأخبار اليوميّة! لكن ماذا ستفعل لو علمت بعلاقة “هزار” و”أدهم”؟ هل سيكونان خبر الموسم؟ “أمّ فراس” لا تؤَمَّن على سرّ! لكن دَمها خفيف، ونجمها محبوب!” (ص 87). الوحدة والحرمان، دفعا “هزار” إلى اكتشاف حقيقة “أم فراس”، فزال خوفها، ولم تعد “أم فراس” مجرد صديقة تأتمنها على أسرارها فقط، بل ارتبطت بها جسدا وروحا، كما بينت سابقا. وهي إشارة واضحة إلى أنّ المرأة التي تختار حريتها وتعي ضرورة النضال من أجلها، إذا نظرت حولها ستجد مثيلاتها اللواتي سيسعدن بالتعاون معها من أجل بلوغ أهدافهن الشخصية والجمعية.
التعامل مع الزمان والمكان في الرواية، كان موفقا من حيث الرسم الفنّي ومن حيث المضمون كذلك. فقد استطاعت الكاتبة أن توازي بشكل فنّي متقن بين الزمن الذي دارت فيه الأحداث وبين الأمكنة التي احتضنتها. من حيث الزمن، فقد توازى تطوّر معاناة البطلة وتمرّدها على المجتمع، مع تطوّر معاناة الجماهير العربية وانفجار غضبها في مظاهرة الناصرة. ومن حيث المكان، فقد كان الربط بين القرية والمدينة، والتنقّل بينهما موازيا للتطور الأحداث على الصعيدين: الشخصي والجمعي. من اللافت كذلك أنّ الكاتبة تعالج في روايتها زمنا حديثا لا يبعد عن صدور الرواية الأول (2010)، أكثر من عقد من السنين، مؤكّدة بذلك على مواكبتها الجادّة لقضايا مجتمعها، وخاصة تطوّر قضية المرأة فيه، وكذلك مواكبتها لقضية شعبها في وطنها الصغير داخل الخط الأخضر، وفي وطنها الكبير، فلسطين، كقضيتين متّصلتيْن متلاحمتيْن لا تحتملان الفصل بينهما، حيث تعي الكاتبة أنّ الفصل بينهما يعني دوام الخلل وبُعد النهاية المرجوة. وقد أشرت سابقا على الأحداث الراهنة في القدس والتي تزيد من مصداقية الكاتبة وروايتها في معالجتها للقضية السياسية.
الشخصيات
لأنّ الأدب النسوي هو الحاضن الأول والأهمّ للرواية، فذلك يُحيل إلى نمطية شخصياتها، حيث تتراءى لنا في غالبيتها شخصيات ذكورية قامعة وشخصيات نسائية تعاني القمع. ولكنّي أعتقد أنّ جرأة الكاتبة وإصرارها على تعرية المجتمع وفضحه، خاصة في سياق مجتمعنا وأدبنا المحلّي، أخرجت بعض تلك الشخصيات، بعض الشيء من نمطيّتها، مثل شخصية البطلة، وشخصية “أمّ فراس”. ذلك لأنّنا لم نكن نتوقّع مثل تلك الجرأة وذلك الإصرار على فضح المجتمع من خلال فضح الأب والأخ والزوج، من كاتبة تعيش في مجتمعنا الذي، رغم كل مظاهر الانفتاح فيه، ما زال يغرق في تعصّبه الاجتماعي وفساده السياسي، الذي يظهر بوضوح في شخصية الأخ، “نزار”، وكونها امتدادا طبيعيا لشخصيتي الأب والزوج.
كل الشخصيات، باستثناء شخصيتي “هزار”، هي شخصيات مسطّحة ثابتة، دخلت عالم البطلة وخرجت منه كما دخلت، بعد أن لعبت دورها الذي يخدم من جهة شخصية البطلة وأهدافها، ومن جهة أخرى يخدم أفكار الكاتبة. من خلال كل شخصية، نقلت لنا الكاتبة فكرة محدّدة، سواء اتّصلت أو لم تتّصل بأفكار الشخصيات الأخرى. يختلف الأمر بالنسبة لشخصية “أم فراس” التي، بدت ثابتة في اعتمادها على نفسها في تدبير حياتها وحياة أولادها، فدخلت عالم البطلة كأرملة ثرثارة جاهلة، ولكنها خرجت منه بصورة تختلف تماما، بعد تعامل البطلة معها واكتشاف أنّها أكثر من صدر حنون تأتمنه على أسرارها. ظهر ذلك جليّا في تشجيعها لـ “هزار” وتشجيع “هزار” لها، الذي انتهى بالعلاقة المثلية التي تمّت بينهما. وظهر كذلك في بكائها الذي عكس ندمها على جهلها وتقوقعها، وعلى ما فاتها من تلبية حاجاتها النفسية والجسدية.
نجحت الكاتبة في رسم شخصياتها بحيث تخدم الهمّ الخاص / الشخصي، والهمّ العام / الجمعي أو الوطني، على المستوييْن، الاجتماعي والسياسي. ظهر ذلك بشكل واضح في شخصيات: الأب والأخ والزوج، كممثّلين للسلطة الاجتماعية والسياسية، و”هزار”، بطلة الرواية، وحبيبها، “نبيل” وسائر الشخصيات، كممثلين لشرائح المجتمع التي تعاني من الظلم والقمع، الاجتماعي والسياسي.
الأب والأخ والزوج، هما تجزيء لشخصية واحدة، استدعته الظروف الاجتماعية والسياسية وأفكار الكاتبة التي تحتاج لأكثر من شخصية لعرضها. شخصية الأب لم تظهر بشكل مباشر في الرواية. تعرّفنا عليها من خلال السرد وبوح البطلة بصور معاناتها التي سبّبها الأب وحزمه في سلوكه الخاضع للقيم المتخلّفة في مجتمع ذكوري متخلّف. من خلال تلك الشخصية أيضا، أظهرت الكاتبة بداية السقوط السياسي الذي مهّدت به ليتجذّر بعد ذلك في سقوط الأخ والزوج. اقتصرت شخصية الأب، كما بيّنت سابقا، على دعوة أبناء عمومته من اليهود، ممثّلي السلطة السياسية ومصالحها في إسرائيل، وإقامة الولائم لهم. يبدو ذلك تمهيدا وتشجيعا للمشاركة المباشرة التي قام بها الأخ والزوج في تلك السياسة بحيث أصبحا جزءا لا يتجزّأ منها: الزوج في خدمته في الجيش الإسرائيلي، والأخ في عمله في المخابرات.
شخصيتا الأخ والزوج هما امتداد لشخصية الأب، اجتماعيا وسياسيا. شخصية الزوج لم تظهر هي أيضا بشكل مباشر في الرواية. تعرّفنا عليها كما تعرّفنا على شخصية الأب، من خلال سرد الكاتبة للمؤامرة التي حاكا خيوطها معا، ضد “هزار”، حيث خضع “كريم”، الزوج، لإرادة الأب، التي قضت بزواجه من “هزار” قسرا. اختارت الكاتبة لشخصية الزوج، الموت كتعبير عن رفضها لوجود مثل تلك الشخصيات، الاجتماعي والسياسي، في حياة المرأة وحياة المجتمع.
لم تختر الكاتبة الموت لـ “نزار”، ليس لأنّه أخو البطلة، ولكن لتبيّن لنا من خلال شخصيته، استمرار المعاناة الاجتماعية والسياسية، وعري الزمن وانتشار رائحته النتنة.فهو من الناحية الاجتماعية، امتداد لشخصية الأب، الشخصية الذكورية التي تقمع المرأة وتهمّش دورها في المجتمع. ومن الناحية السياسية، عميل للمخابرات الإسرائيلية التي تقمع الإنسان العربي وتهضم حقوقه، وتعمل دائما على خضوعه لمصالحها وأهدافها العنصرية التي تُدمّر المجتمع العربي بحرصها على دوام تخلّفه وتفسّخه.
شخصية البطلة، “هزار”، هي نموذج للمرأة المقموعة اجتماعيا، التي تلجأ إلى التمرّد كوسيلة لخلاصها من القمع والشعور بالدونية التي يفرضها عليها المجتمع الذكوري. سفر البطلة إلى الناصرة للمشاركة في المظاهرة، لا يختلف في جوهره عن سفرها إلى حيفا، لأنّ كليهما بالأساس، تعبير عن تمرّدها الاجتماعي ضدّ الر جل الذي يسجنها في البيت ويقيّد تحركاتها. ولكنه يختلف عنه لما فيه من تعبير عن تمرّدها السياسي ضدّ السلطة التي تقمع الإنسان العربي وتساهم بذلك في قمع المرأة. عودة “نبيل” من الغربة ومحاولته استعادة علاقته بـ “هزار”، وانخراطه في العمل الوطني ومشاركته في مظاهرة الناصرة، كل ذلك يصبّ في الأهداف نفسها، الاجتماعية والسياسية. “نبيل” رجل يختلف عن بيئته، ويتمتّع بفكر تقدّمي يحترم المرأة ودورها، ويرى أنّ حياة المجتمع لا تستقيم بدون مساواتها بالرجل ومشاركتها له. ولذلك، فهو يمرّ بتجربة لا تقلّ قسوة عن تجربتها على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي. كلاهما يعيش صراعا مزدوجا، مع المجتمع ومع السلطة. دور “نبيل” يُكمّل دور البطلة في بحثها عن الخلاص الاجتماعي والسياسي لها ولمجتمعها. وبذلك، يُشكّلان على المستوى الاجتماعي على الأقلّ، صورة المجتمع التي تبحث عنها الكاتبة. أمّا على المستوى السياسي فيُشكّلان الوحدة الواعية، بين الجماهير عامة، وبين المرأة والرجل بشكل خاص، تلك الوحدة التي تحتاجها الجماهير العربية في إسرائيل لمواجهة عسف السلطة واستبدادها. ومن اللافت، اختيار الكاتبة لموت “نبيل” في آخر الرواية، فهو يُمثل سهولة قتل المجتمع لحلم المرأة الذي ما زال المجتمع غير مهيّأ لتحقيقه. أعتقد أنّها أرادت بذلك، التعبير عن أنّ رائحة الزمن العاري ما زالت تحتلّ الأنوف والعقول، وأنّ المشكلة الاجتماعية والسياسية ما زالت جاثمة على صدر المرأة والمجتمع، وأنّ الزمن الذي يقف عاريا، ما زال غير مواتٍ لمثل تلك العلاقة التي تربط بين “هزار” و”نبيل”، بين الرجل والمرأة، وأنّ الوضع الاجتماعي والسياسي ما زالا يتطلّبان الكثير من التمرّد والتضحيات والضحايا لتغييرهما.
لم يكن ممكنا أن نفهم معاناة البطلة، بدون الشخصيات الأخرى التي تُكمّل دورها أو تخدمه. وبشكل خاص الشخصيات النسائية، سواء تلك التي ظهرت في الرواية بشكل مباشر أو غير مباشر. الشخصيات النسائية المهمّة في حياة البطلة، والتي ظهرت بشكل غير مباشر، مثل أمّ البطلة وأختيْها: “منية” و”دلال”، سبق لي أن تحدثت عن دور كل منها. هذه الشخصيات كانت ضرورية جدا، فقد عبّرت عن فهم الكاتبة لشكل الظلم وتاريخيّته واستمراريته. تلك الشخصيات، أثرت الرواية بمساهمتها في إبراز صورة الظلم اللاحق بالمرأة في المجتمع الأبوي الذكوري.
أربع شخصيات نسائية أخرى، ظهرت في الرواية بشكل مباشر ساهمت في نقل جانب من أفكار الكاتبة، وفي تجسيدها لمعاناة المرأة في الزمن الراهن، وطرح رؤيتها للمستقبل؛ في تصويرها للواقع الذي تتمرّد عليه وتهدمه، وفي تجسيد رؤيتها للمجتمع المنشود الذي تبحث عنه وتسعى لبنائه.
“لورا”، زوجة “نبيل” التي تزوّجها في الغربة، تعبّر عن وجود امرأة ثانية في حياة الرجل تُعقّد مشكلة المرأة معه، ولكنّها في الوقت نفسه، وذلك هو الأهمّ، تسلّط الضوء على مشكلة المرأة مع نفسها أو مع المرأة الأخرى حين تقف المرأة عائقا أمام حلّ مشكلتها. مثل تلك الشخصية هي شخصية نمطية نصطدم بها في كل روايات الأدب النسوي العربي وغيره.
“السيدة جميلة”، المرأة التي سكن “نبيل” في منزلها، هي امرأة عربية ريفية بسيطة، تكره الظلم بالفطرة. ولذلك فهي تخاف على “نبيل” وتقلق لأوضاعه المحزنة، وتعتبر الذين يعتدون عليه “أولاد حرام” (ص 194). “السيدة جميلة” تعرف بحسّها النسوي، بنوعية العلاقة بين “نبيل” و”هزار”، ولا تعتبرها عيبا ما دام قصده شريفا وقد طلّق زوجته. “الحُبّ مُشْ عيب، وإن كان قصدهُ شريف فلا تُبالي … ها هوَ طلّق “لورا” وافترقا” (ص 196). ولذلك فهي تستقبل “هزار” في بيتها، وتزورها، تدعمها وتنقل لها أخبار “نبيل”.
من خلال شخصية “السيدة جميلة” تظهر الكاتبة القيم العربية الأصيلة التي تقوم على الاحترام الفطري للإنسان وحريته، وتنبذ الظلم والتحكّم بمصائر الناس. كذلك تعبّر عن أهميّة التكافل الاجتماعي، والتواشج والتعاون كأسس يجب أن يقوم عليها المجتمع الذي تسعى الكاتبة لبنائه. لغة الحوار التي جرت على لسان “السيدة جميلة” شوّهت صورتها قليلا، وانتقصت من فطريّتها. سأبيّن ذلك في حديثي عن اللغة.
“سمر”، هي ابنة “هزار” بطلة الرواية. وهي شابة في مقتبل العمر وطالبة جامعية، تشارك زملاءها في نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية. هذه الشخصية خلقتها الكاتبة لتكون امتدادا مغايرا لأمّها، بحيث تعبّر عن المستقبل المتفائل الذي تبحث عنه البطلة والكاتبة معا. ولذلك نجد أنّ أمّها، بطلة الرواية، تنازلت عن كثير من حريتها وحقوقها من أجل تربيتها وتثقيفها بما يلائم المستقبل المنشود. كما أنها دافعت عنها وحمتها من قيود المجتمع الأبوي الذكوري المتمثّل بخالها “نزار” الذي حاول بسط هيمنته على الأمّ وابنتها، وعارض ذهاب “سمر” للجامعة وخروجها الحرّ مع زملائها. وهنا يمكن أن نضيف سببا آخر لاختيار الكاتبة موت “كريم” في طفولة ابنته، “سمر”. فقد عبّرت الكاتبة بذلك عن رفضها للمجتمع الأبوي وقيمه الذكورية، ورفضها في أن تُشكّل تلك القيم أساسا في تربية الأجيال القادمة التي يجب إعدادها لمستقبل مختلف، يحترم المرأة ويؤمن بدورها في بناء المجتمع.
وأخيرا، شخصية “أم فراس”، هذه الشخصية يُمكن اعتبارها إشكالية بسبب الأفكار والقيم التي تُمثّلها، والتي تعبّر عن جرأة الكاتبة التي أخرجتها عن نمطيّتها. تلك الشخصية، يُمكن أن تُثير جدلا في أوساط المجتمع المختلفة، فهي تجمع في مكوّناتها أكثر من رمز يحيل إلى جوانب مختلفة من حياة المجتمع وأفكار الكاتبة. إنّها أرملة اعتمدت على نفسها في تربية أولادها بعد موت زوجها، ما يُحيل إلى أنّ المرأة العربية أيضا تستطيع أن تستقلّ عن الرجل في تدبير أمورها الحياتية. ولكنّها كأرملة أيضا، تحمل في داخلها، فقدها وحنينها للرجل تعبيرا عن رغبتها في تلبية حاجاتها الجسدية التي يمنعها عنها المجتمع، الذي ربّاها على الخوف من جسدها والجهل بقدراته على تلبية حاجاته بنفسه، أو مع امرأة أخرى دون التعرّض للصدام مع المجتمع الذكوري الذي لا يعترف بحاجاتها النفسية والجسدية، فيُقيّدها ويُحرّم عليها تلبية تلك الحاجات، باعتبارها دمية خُلقت لتلبية حاجات الرجل. ممارسة “أم فراس” للجنس المثليّ مع البطلة، جاءت تعبيرا عن اكتشاف قدراتها الذاتية، وتعبيرا عن الحرية التي تفتقدها هي شخصيا، والمرأة عامة في المجتمع الأبوي الذكوري. وعليه، فإنّ لقاء “أم فراس” بالبطلة ينطوي على مفارقة تفضح المجتمع وقيمه الذكورية التي تقوم على تقديس الرجل. ففي الوقت الذي تنطلق فيه “أم فراس” من تجربة حرمانها وتدفع البطلة إلى ضرورة العلاقة مع الرجل، تدفعها البطلة إلى ضرورة اكتشاف جسدها والتمتّع به بدون الحاجة للرجل. “أم فراس” هي شخصية مستديرة، فاجأتنا الكاتبة بقدرتها عل الإدهاش. فهي لم تخرج كما دخلت، وإنّما أثّرت بالأحداث وتأثّرت بها، ساهمت بتغيير شخصية “هزار” كما ساهمت “هزار” في تغييرها. خرجت وقد تركت في نفس القارئ متعة الإحساس بجمالية الرواية، ومتعة الإحساس بنكهة الجنس المختلفة، التي يُوظّف فيها الجنس ليس للتعبير عن مشروعية الحاجة إليه فقط، وإنّما كتقنية للتعبير عن أهداف فكرية تتعلّق بالحرية وفضح المجتمع والانتقام منه.
سبق لي الحديث بتوسع، عن شخصيات ذكورية أخرى، هي: “الجنّان” و”أدهم” وعمّ البطلة. هذه الشخصيات تمثّل أشكالا مختلفة من الجنس المرفوض أو المرغوب، وتأثير ممارسته على شخصية المرأة، كما تُعبّر عن استغلال الرجل للمرأة وجسدها في المجتمع الذكوري كأداة لتلبية حاجات الرجل الجسدية.
اللغة
لا شكّ أنّ لغة الرواية تأثّرت بلغة الكاتبة كشاعرة مارست كتابة الشعر لسنين طويلة قبل كتابة الرواية. فهي لغة ترقى بكثافتها ورومنسيتها إلى لغة الشعر في معظم فصول الرواية. وقد وظّفت الكاتبة لغتها بشكل يلائم استعدادها للبوح الجريء والحفر الأعمق في طبقات لاشعورها، غير ناسية أنّها لم تستطع تحقيق ذلك في قصائدها، وأنّ مولودها الأول الذي رعته لسنين طويلة، لم يسعفها ولم يُحقّق لها الخلاص. وهو ما دفع بها إلى البحث عن خلاصها في الرواية التي يهتمّ كتّابها بشعريتها وشعرية لغتها التي تتميّز رغم كثافتها، بقدرتها على الكشف والتعرية والفضح. وقد لجأت الكاتبة عند الحاجة إلى اللغة المباشرة، وقد نجحت في المزاوجة بين اللغتين، المباشرة وغير المباشرة، نجاحا لافتا على امتداد الرواية. سأكتفي هنا بتقديم نموذجين لذلك، على سبيل المثال لا لحصر. الأول في العبارة التالية، حيث نلاحظ فيها كيف تتحوّل الكاتبة من اللغة المباشرة إلى اللغة غير المباشرة في قولها “وتبني لنفسها بيتا أرجوانيا“، إلى آخر الفقرة: “كانت تهرولُ إلى الغابةِ القريبةِ من منزلها، في تلكَ القريةِ الرّابضة على قمّة الجبل، فتُروّح عن نفسها، وتلتقط الهواءَ النَّظيف، وتبني لنفسها بيتًا أرجوانيًّا، يعبقُ برائحةِ الأقحوان والنّرجس البرّيّ!” (ص 21). والثاني في العبارة التالية: “التحمَ الجسدان، ولم يتكلّم “أدهم”، و”هزار” أغمضت عينيْها، لتغطّ في حلمٍ عميق، يوقظ سبات العمر الّذي ضاعَ من بينَ أنفاسها … اقتربَ أكثر وأكثر والتصق بها، مداعِبًا سواحل بحرها … أحسّت بنشوة غريبة، وأطلقت لنفسها العنان!” (ص 85)، يظهر التحوّل واضحا حين تقول “اقتربَ أكثر وأكثر والتصق بها، مداعِبًا سواحل بحرها”.
برزت كثافة اللغة منذ العنوان، حيث جعلني أتخيّل إحساس الكاتبة أنّ لأجسامنا رائحة، طيّبة لطيفة أحيانا وفاسدة كريهة أحيانا، وهي مثيرة في الحالين، جذّابة بجمالها ولطفها ومنفّرة تُثير اشمئزازنا بفسادها وكراهتها. وحين نتعرّى تتدفّق رائحة أجسادنا أكثر فتتضاعف جاذبيّتها لدرجة أنّها تُثير شبقنا أحيانا، أو يتضاعف اشمئزازنا منها ورفضنا لها. ولكن، هل للزمن جسد ورائحة؟ وهل يتعرّى الزمن فتتدفّق رائحته أكثر؟ ترى الكاتبة أنّنا نحن، معشر الناس، جسد الزمن، ورائحته هي رائحتنا، الطيبة الجذّابة أو الكريهة المنفّرة. ولذلك، في روايتها “رائحة الزمن العاري”، وبهذا العنوان، كملمح ميتاقصّيّ، تُحيلنا الكاتبة إلى الأجواء الفاسدة التي تعرّيها الرواية، تلك الأجواء التي أفسدها فساد النفوس الأمّارة بالسوء، والتي تدفع بأصحابها إلى أفعال السوء التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفّرة تُفسد الزمان والمكان، الزمان بثالوثه: الماضي والحاضر والمستقبل، والمكان برجاله ونسائه، بأفراده وجماعاته، وما يربط بينهم من علاقات شخصية واجتماعية وسياسية. تلك الرائحة، رائحة الزمن العاري، الذي عرّته أيدينا، تدمرّ حياة الكاتبة وحياة المجتمع بأسره. الزمن العاري، أصاب الكاتبة بحالة من الخوف واللقلق والضياع، كشفت لها كم هي كريهة ومنفّرة تلك الرائحة. لذلك تأتي “رائحة الزمن العاري”، الرواية والمعاناة، تجسيدا لمأساة الكاتبة وبطلة روايتها، تفضح فيها مصادر الرائحة، رموز مجتمعها / مجتمعنا المثقل بموروثه الاجتماعي المتخلّف وحمولته الذكورية الفاسدة. تفضح الرجال الذين اجتمع لديهم تخلّف الفكر الأبوي الذكوري وفساد الممارسة الشخصية والاجتماعية، فعرّوا بممارساتهم الزمن وأفسدوا رائحته، إذ باعوا أنفسهم لشيطان الشهوة والسلطة، فأذلوا نساءهم واستباحوا أعراضهنّ، وهان عليهم الوطن فاستباحوه وباعوه هو أيضا. تهبّ الكاتبة من رماد مأساتها، لتفضح تلك الرائحة، ولتحاكم وتعرّي وتنتقم ممن عرّوا الزمن وأفسدوا رائحته. تتمرّد بلغتها التي تصرخ وتفضح وتُحذّر وتنتقم، تفكّك بنى المجتمع وتقوّضها لعلها تستطيع أن تُشيّد باللغة، مجتمعا أفضل ومستقبلا واعدا أكثر.
من الصعب اختيار نموذج واحد للغة الكاتبة التي تتمتع بكثافة الشعر ورومنسيته، لأنّ المونولوج الداخلي للبطلة يمتدّ أحيانا على صفحات تُثير الإحساس لدى القارئ أنّ الرواية كلها عبارة عن مونولوج واحد متواصل ينتهي بنهاية الرواية. ومع ذلك فإنّ ما تُناجي ما به البطلة نفسها في لحظة لقائها بـ “نبيل” واثناء امتداد يده لمصافحتها في الصفحة (13)، يصلح نموذجا جيدا. وهذا ما نلمسه أيضا في الفصل الخامس وخاصة في صفحاته الأخيرة، في تساؤلات “هزار” ومناجاتها لنفسها.
في تعبيرها عن الجنس كانت الكاتبة موفقة أيضا إلى حدّ بعيد. فقد برزت انتقائيتها للغة الجنس التي جاءت أوصافها وتعابيرها، تتميز بكثافتها وإثارتها في آن معا. ورغم أنّها لم تُخْفِ جرأتها في الوصف، فقد ابتعدت فيه عن الألفاظ والتعابير المبتذلة التي قد تحوّل الجنس والحديث عنه إلى فعل داعر يُثير اشمئزاز القارئ وينسيه القضية التي جاءت الرواية لتستفزّه من أجلها. ولذلك فقد تنوّعت مشاهد الجنس بين المرفوض الذي مارسته قسرا، كما حدث للبطلة مع “الجَنّان” وعمّها، وبين الجنس المرغوب الذي مارسته طوعا ورغبة مع “أدهم” و”نبيل”.
المشاهد كثيرة، سأكتفي منها بثلاثة: المشهد الأول، يمثّل الجنس المرفوض، الذي يلتقي به الجسد بالجسد قسرا، حيث نلمس في محاولة اغتصاب “الجَنّان” للبطلة، كيف ارتفعت لغة الكاتبة إلى مستوى الحدث فزاوجت بين وحشية الفعل وهمجية الفاعل، وبين رقة المفعول به وحرمانه وضعفه، حين تقول: “هذا الوحش المتصبّب عرقًا ولهاثًا، بكفّيْه الغليظتيْن احتوى نهديْها يمتصّ العنّاب بشفتيْن نهمتيْن، وتناثرت صرخةُ جسَدِها في فقاعات الصّابون!” (ص 35). هذه اللغة التي تزاوج بين اللغة المباشرة والكثيفة. تفضح وحشية “الجَنّان” وضعف البطلة وحرمانها، وفي الوقت نفسه، تُبيّن مقاومتها ورفضها الذي يُمثّل رفض الكاتبة لهذا النوع من الجنس.
المشهد الثاني، يمثّل الجنس المرغوب، ولكن الجنس الذي يلتقي فيه الجسد بالجسد فقط، كتعبير عن الرغبة والحرمان. مارسته البطلة طوعا ورغبة مع “أدهم”. تقدّم الكاتبة المشهد بلغة عالية الكثافة تعطي القارئ فرصة للانطلاق بخياله باحثا عن متعته في إحساسه بموجودات المكان التي تُصورّها الكاتبة كأنّها تشارك بالفعل. فالثوب لم يعد أرجوانيا، والفكر هو الذي يتعرّى وليس الجسد، والستائر هي التي تشهق وليس من يُمارس الفعل، وهكذا، كما في الفقرة التالية: “لمْ يعد لونُ ثوبها أرجوانيًّا، وفِكرُها تعرّى خلال لحظات، فشَهقت السّتائِر، وضجّ الجسدُ برغبة تتوحّش، وتتمطّى الشّهوة على سرير الحرمان، وكؤوس النّبيذ الفارغة بحياء تسترق النّظر، وتعود تحملقُ في جدران الغرفة، والسّتائر المخمليّة حدّ الشّهقة الحالمة، تجازف في احتضان نور شمعة مضاءة باشتعال الفضاء في الرّكن! التحمَ الجسدان، ولم يتكلّم “أدهم”، و”هزار” أغمضت عينيْها، لتغطّ في حلمٍ عميق، يوقظ سبات العمر الذي ضاعَ من بينَ أنفاسها … اقتربَ أكثر وأكثر والتصق بها، مداعِبًا سواحل بحرها … أحسّت بنشوة غريبة، وأطلقت لنفسها العنان! (ص 84-85).
والمشهد الثالث، يمثّل الجنس المرغوب، الذي تلتقي فيه الأجساد والأرواح، لأنّه نابع عن حبّ يجمع بينها. وقد مارسته البطلة مع حبيبها، “نبيل”، في مقطعين منفصلين. تقول في الأول: “امتدّت أصابعه تلامسُ خصلاتِ شعرها، وترفرفُ فوق خَدَيْها بملمسٍ من حرير، وإلى شفتيها تمتدّ شفتاه، ثمّ ترسم قبلة فوق جبينها … استسلمت بكلّ جوارحها، متناسيةً “نزار” و”سمر” وجارتها “أُمّ فراس”! بين يديه هي الآن، وحدهما ولحظة أزليّة كم انتظرها عمرها كلّهُ، فكيف تبخل بها عليهما؟! تلوّنت يداه بلمساتها المتصاعدة لهيبًا في أنحاء جسدها، إلى وجنتيها … عنقها … صدرها … خاصرتها … ليتأجّج بالرّغبة، ويغدو شعلة نار تتشهّى، وتزيل ستار الخجل المسدل على لوحة جسدها المتحفّز للاحتراق!” (ص 109-110). وتقول في المقطع الثاني: “لم تَعُد زهرة الأقحوان تطلُّ من وراء النّافذة خجلاً، فكلّ الأشياء تصمت رهبة، ويصمتُ النّبضُ ورائحة الأنفاس اللاّهثة، وتشتعل شِفاهٌ أرهَقَها الحِرمان، ويصمت جَسَدان عاريان إلاّ من اشتعال الأحاسيس!” (ص 180). في المشاهد السابقة، وفي غيرها الكثير في الرواية، كانت اللغة مطابقة لدوافع الجنس في غير تهتّك أو ابتذال. وكانت ترقى إلى عذوبة الشعر ورومنسيته، خاصة في تلك المشاهد التي تعبّر عن الجنس المرغوب بنوعيه.
ما تقدّم، لا يمنع أنّ لغة الرواية كانت تقع في مطبّ اللغة المباشرة أحيانا، ما أدّى بها إلى الترهّل والتقعّر، خاصة في الحوار المباشر بين البطلة وبعض الشخصيات الأخرى. “السيدة جميلة” و”أم فراس”، هما شخصيتان عاديتان من نساء القرية البسيطات غير المتعلمات. ومع ذلك فقد كانت الكاتبة، في حوار البطلة معهما، تُجري على لسانيهما لغة لا تتفق مع موقعهما الاجتماعي والثقافي. فرغم أنّ الحوار بين الشخصيات كان باللغة الفصحى غالبا، إلّا أنّه كان ينحدر إلى اللغة العامية أو إلى أسلوبها أحيانا. ولكن ليس ذلك ما ينتقص منها، وإنّما تلك الفصحى التي كانت تنطق بها “السيدة جميلة” أحيانا، فهي تلائم أكثر، لغة الروايات أو المسلسلات التلفزيونية الغربية المترجمة والمدبلجة. مثلا، تقول السيدة جميلة: “أنا بخير عزيزتي، لكنّني حزينة لما حدث لـ “نبيل”، والله لا أُصدّق ما حَلَّ به، هذا الإنسان الرّائع!” (ص 160). أو “ماذا دهاكِ يا حبيبتي؟” (ص 161). هذه اللغة على تقعّرها وعدم ملاءمتها لشخصية “السيدة جميلة”، إلّا أنّها أيضا لا تلائم شخصية عربية، بل تلائم كما ذكرت شخصية أجنبية عُرّبت لغتها. ربما خفّف لفظ القسَم، “والله”، في العبارة الأولى، من حدة ذلك بعض الشيء، ولكن لو كانت اللغة عامية لجاءت أكثر صدقا. كذلك اختيار الاسم، “السيدة جميلة”، لا يخرج عن الإطار المذكور، إذ تفوح منه رائحة برجوازية غير موجودة عند الشخصية. ألا تحتمل لغة الرواية أمّاً أخرى غير “أم فراس”، أو اسما آخر يناسب مستوى شخصية “السيدة جميلة” الاجتماعي والثقافي، مثل “أمّ جميل” أو تخفيف الفصحى فيه ليصبح “الست جميلة” بدل “السيدة جميلة” التي تُذكّرنا، كما قلت، بالأفلام الغربية المترجمة أو المسلسلات المدبلجة؟
الأمر يبدو أكثر حدّة في شخصية “أم فراس”. هنا، يمكننا أن نتفهّم خضوع “أم فراس”، بسبب حرمانها الطويل، لـ “هزار”، عندما لامست جسدها وعبثت بكل عضو فيه (ص 148)، وإن كان التفهّم يكتنفه الكثير من التحفّظ ليس بالنسبة للأسباب والدوافع فقط، وإنّما بالنسبة للغة أيضا، إذ حتى لو تفهّمنا لغة “أم فراس”، من باب أنّ الحوار في الرواية جاء كله على هذا النسق، مع أنّه يبدو لي أنّ الكاتبة كانت قادرة على المزاوجة أكثر بين العامية والفصحى والابتعاد عن التّقعّر، ولا أدري ما الذي منعها من ذلك، لا يُمكن أن أتفهّم، تلك القفزة في اللغة والخطاب، حيث الكاتبة بعد وصفها “أم فراس” بأنّها امرأة “أمّيّة لا تقرأ إلّا فنجان القهوة، وليس لها علاقة بالكتب أو بأيّ نوع من الفنون” (ص 146)، ارتقت بلغتها وخطابها إلى ما لا يمكن تبريره، مهما كانت شخصية “أم فراس” ذكية، وذلك في قولها عن “نزار” في فصل سابق: “هو ينوي الشّرّ لـ “نبيل”، ويريد تهجيرهُ مرّة أخرى، لأنّ فِكْرَ “نبيل” يشكّل خطرًا على القرية وعليكِ” (ص 125)؟ أعتقد أنّ اللغة والخطاب نفسه في هذه العبارة لا ينسجمان مطلقا مع الوضع الاجتماعي والثقافي لمثل تلك الشخصية.
كانت الكاتبة موفقة أيضا في اختيارها للأسماء، فلكل اسم دلالته أو دلالاته التي عبّرت عن أهداف الكاتبة منه، إلّا السيدة جميلة. الاسم “جميلة” بحدّ ذاته كان موفقا، إذ يحيل إلى جمال نفس صاحبته وتعاطفها مع البطلة وحبيبها. ولكنّ “السيدة”، تلك الصفة التي ألصقتها الكاتبة بالاسم لم تكن موفقة، كم سبق أن بيّنت.
“هزار”، اسم جميل لا نجده بكثرة في مجتمعنا، ما يحيل إلى ثورية الكاتبة وفرادة شخصية البطلة. وهو طائر صغير له صوت رقيق وجميل، ما يُشير إلى رقّة “هزار” وجمالها. غناء الهزار خارج السرب يُبرز جمال صوته. و”هزار”، بطلة الرواية، هي أيضا طائر يُغرّد خارج السرب، وصوتها المتميّز يفضح الأصوات النشاز الكثيرة في المجتمع، التي تحاصرها وتحاول خنق صوتها. قلّة تداول الاسم تحيل إلى قلّة النساء اللواتي يتمرّدن على المجتمع، ويصرخن بوجهه بالشكل الذي قامت به البطلة. ولذلك فالبطلة، ومن ورائها الكاتبة التي تدفعها، يُعتبر صوتها دعوة أو صرخة في وجه النساء المقموعات ليتمرّدن وينضممن إليها في ثورتها، ما يُؤكّد أن همّ “هزار” هو همّ شخصي وجمعي في آن معا.
“نبيل”، فيه الكثير من سمو الروح وعفاف النفس وشرف الأخلاق، أرادته الكاتبة نموذجا للرجل الذي تبحث عنه بطلة روايتها، فهو بالنسبة لها الحلم الشخصي، وكذلك حلمها الجمعي بمجتمع يكون رجاله على صورة “نبيل”.
“لورا”، اسم أجنبي يعني في اللغات ذوات الأصل اللاتيني، الهالة أو إكليل الغار. ربما جاء اختياره تعبيرا عن أنّ زواج “لورا” من “نبيل” كان نصرا على “هزار”. ولكنّه نصر مؤقت، لأنّ خروجها من حياة “نبيل”، بسفرها وطلاقها منه، يعني هزيمتها وانتصار “هزار”، ويعني أنّ هزيمة “هزار” هي أيضا كانت هزيمة مؤقتة، أو خسارة لمعركة وليس للحرب.
“كريم”، هذا الاسم تُوظّف فيه الكاتبة السخرية المبنيّة على المفارقة. فهو في دلالاته اللغوية يجمع الكثير من الصفات الخيّرة: كرم الكفّ، كرم النفس، كرم الأخلاق، وغيرها الكثير من الفضائل. ولكن، إذا تتبعنا شخصية “كريم” في الرواية، نجدها تفتقر لتلك الصفات جميعا.
“نزار”، أشعرّ أن الكاتبة لم تُحقّق كل ما أرادته بهذا الاسم. فهو رغم أنّه يعني القليل من كل شيء، إلّا أنّه لا يتّسع لقلّة الخير التي تتمتع بها شخصية “نزار”. فنذالته وتفاهته ونفعيّته وعمالته ومعاملته الخسيسة لأخته وأبناء مجتمعه، أوسع من أن يتسع لها الاسم، “نزار”.
“سمر”، بما أنّ السمر يكون ليلا، فإنّ الكاتبة اختارت الاسم لابنة “هزار” لترسم بها أنيس وحدتها وسمير ليلها أو حاضرها الأسود وحلم مستقبلها القادم لا محالة. في رسم شخصية “سمر” واختيار اسمها، الكثير من التفاؤل الذي يساعد “هزار” على تحمّل مأساتها ومواصلة طريقها.
“أدهم”، الليل الأسود الحالك، يُقيّد حركتنا ويشلّ تفكيرنا، إلّا أنّنا نعشقه لغموضه تفاؤلا بما يليه من نور الصباح. ولكنّ الصباح أحيانا يأتي متأخّرا، بعد أن تكون حلكة الليل قد فعلت فعلتها. وهذا بالضبط ما حدث لـ “هزار” مع “أدهم”. عشقته لحرمانها، ولاعتقادها بتميّزه عن الآخرين. لعلّها أرادت به أن تفجّر صبح حريتها. لكنّه لم يتركها إلّا بعد تركه ندبة سوداء على جسدها وجرحا لا يندمل في نفسها.
“أم فراس”، فراس هو الأسد، وهو ذو الفراسة الذكي الحاذق الماهر بمعرفة بواطن الأمور. اختيار الاسم جاء تعبيرا عن قوة الشخصية وفراستها، حيث قامت بدور الأم فتصرفت بقوة وذكاء. بعد موت زوجها، وضعت لنفسها برنامجا سارت عليه فدبّرت به أمور حياتها وحياة أولادها. ولكنّ الوجه الآخر لفراستها هو الأهمّ في رسم شخصيتها، حيث استطاعت بها أن تطّلع على دخيلة “هزار” وحاجاتها النفسية والجسدية. وأكثر من ذلك وعيها للتماهي بينهما في تلك الحاجات، الأمر الذي دفعها إلى التجاوب مع “هزار” تلبية لحاجاتهما المشتركة.
لا تخلو لغة الرواية من السخرية التي تنضح ألما وفضحا للمجتمع والمتورّطين فيه بالظلم والفساد. سبق لي أن ذكرت توظيف المفارقة في اسم “كريم” لتعريته وفضحه. السخرية في الرواية، قامت على تقنيّاتها الأربع: المفارقة (إرونيا)، التناقض (برادوكس)، المثالية (يوتوبيا)، المسخ أو التشويه (غروتسك). فقد مسخت “الجَنّان” وحشا بقولها: “هذا الوحش المتصبّب عرقا ولهثا، بكفيه الغليظتيْن” (ص 35). ولتعبّر عن ألمها، تسخر البطلة من نفسها أحيانا، سخرية مبطّنة نستشفّها من مناجاتها لأختها، “دلال”، التي انتحرت قسرا، حيث تقول: “أَحسدُكِ يا “دلال” … بل أُغبّطكِ يا الشّجاعة المتمرّدة! كلّما شدّت أمّي بضَفيرتكِ، كُلّما صرختِ في وجهها: أنا الإنسانةُ ولستُ “النّعجة”، فالنّعاج تنامُ بصمتٍ، “ودلال” لم تولدْ للصّمت!” (ص 29). في هذه العبارة تسخر “هزار” من صمتها هي وعدم تمرّدها حين حدث ما حدث لأختها. وتبلغ اللغة حدّ السخرية السوداء التي تنضح ألما وحسرة، ولكنّها في الوقت نفسه، تفضح أولئك الذين ليس لديهم طريقة لتحقيق رجولتهم إلّا قمع المرأة وتلطيخ شرفها واغتصاب حقوقها. وأولئك أنفسهم هم الذين لطّخوا شرف الوطن وباعوا أراضيه. يظهر ذلك عندما تتابع مناجاتها لأختها. تقول: “لم ترحمك ألسنة اللهب في القرية، فهل استشهادك في سبيل انسانِكِ وكيانك كان شهادة؟ لو أنّ موتك كان في سبيل الوطن، لنثروا على قبرك الورود، وكللوك بأوراق الغار، وتوّجوك أوسمة البطولة مثل أيّ “شهيدة” (أي سيتظاهرون نفاقا بحبّ الوطن)! وهل بقي خيتاه وطن (وقد باعه هؤلاء العملاء والسماسرة المنافقون)؟” (ص 30). تستشهد الكاتبة بالعبارات المثالية، مثل الشهادة والموت في سبيل الوطن ونثر الورود وأكاليل الغار، لتبرز الحقيقة المقلوبة، حيث تكلّل العملاء المنافقون بأوراق الخزي وأوسمة العار.
ولا يبتعد المعنى عن ذلك حين تسخر “هزار” من “كريم”، زوجها القسري، حين تنعته بـ “كريم فارسُ الوطنِ، حاملُ البندقيّة ورجلُ الرّصاصِ، بدلتُهُ كاكيَّة ونجوم لامعة على كتفيه! إنّه حارسُ ليلِ الوطن! يا للسّخرية”. وتتابع ساخرة من كل الرجال: “هكذا يفوزُ الرّجالُ في معارِكهم، برجولةٍ تُبهرُكَ ببريقها، فداءً للأرضِ والعرضِ … وأيّ أرضٍ وأيّ وطنٍ، و”نبيل” وكلّ قصصهِ وشهاداته الجامعيّة خانتهُ الآن؟!” (ص 17-18). السخرية هنا مبنية على المفارقة، فحارس الوطن هو في الحقيقة خائن الوطن وحارس ليله، وفوز الرجال هنا، هو ليس أكثر من فوز مزيّف، أو هزيمة نكراء. ثم يفيض ألمها مما آلت إليه حالها بعدما أرغمها أبوها على الزواج من “كريم”، فنفثته بغضا وسخرية، فضحا وانتقاما حين تقول: “وجهي كرغيفِ الخبز البائسِ بصفعةِ الأيّام وكفّ أبي … وسريري يتلوَّى جريحًا، بعدما أصبحتُ زوجة لوسيم الطّلعة، للجنديّ الباسل، صاحبِ المراتب والأوسمة” (ص 18). السخرية تقوم هنا على المثالية فهي تطرح صورة مثالية لتسخر منها في تثبيت نقيضها لا تثبيتها. تُؤكّد ذلك حين تتابع: “أتدري يا أبي؟ كم أكره رائحةَ البنادق، وصوتَ الرّصاص الخائن، وخيانة الوطن وخيانة الذّات؟” (ص 18). وتتابع سخريتها من “كريم” ووالدها معا حين تقول: “كَمْ كرهتْ تلك البدلة الّتي تآمرت مع شاربَيْ والدها على جلْدِ أحاسيسها”. وتسخر من والدها الذي مهّد لزوجها وأخيها طريق السمسرة والعمالة، ومن المنتفعين من سمسرته وعمالته، أولئك الذين كان يقيم لهم الولائم، ” أبناء عُمومتهِ “اليهود”، الّذين أخلص لهم ولدولتهم! لم يكن هؤلاء سوى أصحاب مصالح ومطامع، اشترَوْا أراضي القرية، واستولَوْا على قسمٍ كبيرٍ منها! هُم المنتفعون من الأرض، ومن ملْءِ بطونهم بالطّعام اللّذيذ من “المناسف بالأرز وَاللَّحمة” (ص 27). هنا تعتمد السخرية على المفارقة، لأنّ مثل تلك الأطعمة العربية الأصيلة واللذيذة، يُقدّمها العربي المضياف عادة لضيوفه الأعزاء المرغوبين الذين يتشرّف البيت وأصحابه باستقبالهم واستضافتهم. والمضيف هنا ليس مضيافا بل مرغما، والضيوف ليسوا مرغوبين بل غاصبين منتفعين.
لا تنضب السخرية ما لم ينضب الألم. ولذلك، كانت تلك نماذج قليلة من الرواية وليس كل ما فيها. والرواية كلها، هي زفرة ألم تفجّرت في أعماق هيام قبلان وبطلة روايتها. تلك الأعماق التي تغلي كالمرجل ألما وغضبا. وقد كانت السخرية إحدى التقنيّات الفنية التي فضح بها الكاتبة جلّاديها وجلّادي الوطن وانتقمت منهم.
* * * * *
في نهاية هذه الدراسة، أخلص إلى القول: إنّ هيام قبلان خاضت تجربة روائية موفّقة، استطاعت بها أن تٌحقّق خلاصها الذي عجزت عن تحقيقه في الشعر. فقد أطلقت بروايتها صرخة عرّت الزمن وفضحت رائحته، فقد عرّت وفضحت وانتقمت. انتقمت جلّادها وجلّاد شعبها، المتمثّل بالسلطتين: الاجتماعية والسياسية. وقد انتصرت فيها لنفسها ولبنات جنسها ولمجتمعها بأسره. والأهمّ من ذلك كله أنها كتجربة أولى، تبدو تجربة واعدة أرجو أن يُكتب لها الاستمرار. وأخيرا، رغم كثرة ما قلت، أخلص إلى القول أنّ الرواية ما زالت تحتمل أكثر مما قلت. فلعلّ نقادا آخرين يرون غير ما رأيت ويُصوّبونني حيثما أخطأت.
(كابول: 02.12.2014)

هوامش
[1] . هيام قبلان. رائحة الزمن العاري، نابلس: بدون اسم الناشر أو المطبعة (طبعة شخصية)، ط 2، 2012.
[2] . موقع الشروق: 18.10.2012. http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08102012&id=a57cf749-2958-4892-92c6-26309785820c
[3] . د. هـ. لورانس. عشيق الليدي تشاترلي، ترجمة: حنا عبود، دمشق: ورد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1999.
[4] . ميجان الرويلي وسعيد البازعي. دليل الناقد الأدبي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط 2، 2000. ص 223.
[5] . المصدر نفسه.